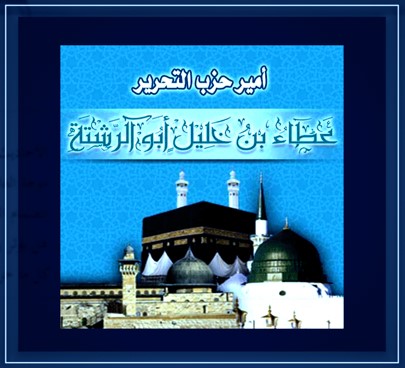تعاني البشرية منذ سنوات أو قل منذ عقود من انخفاض قيمة العملات الورقية، بمعنى فقدان العملة لقوتها الشرائية، مما أدى بشكل طبيعي إلى ارتفاع في الأسعار، وفي المقابل فإن متوسط الأجور في كل بلد لم يرتفع بشكل يغطي هذا الانخفاض في القوة الشرائية لعملة كل بلد. ولكن هذا ليس هو جوهر الضنك المعيشي.
والطمع والاحتكار الرأسمالي مشكلة حقيقية، حيث أصبح الإنسان في العالم، وليس فقط في بلدان العالم الإسلامي، يشعر في نفسه وكأنه مجرد آلة تعمل ليلا ونهاراً ليستطيع تغطية نفقاته الأساسية اللازمة له ولأسرته، محاولا ما استطاع أن يبقى صامداً أمام فواتيره والتزاماته الشهرية التي تزداد شهراً بعد شهر وسنة بعد أخرى، ومع ذلك فليست هذه هي المشكلة الجذرية ولا الوحيدة.
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، إن لم تكن الأسعار بارتفاعها هي جوهر المشكلة والأزمة والمعاناة، وإن لم يكن الاحتكار وجشع الشركات الرأسمالية هو المشكلة الجذرية، فما هو السر إذن وجوهر المشكلة في دوران الناس في رحى الدنيا، يركضون صباح مساء لسد احتياجاتهم وتأمين حاجياتهم؟
وحتى نرى الصورة بشكل أوضح، سنركز قليلا على ماهية النفقات التي أرهقت كواهلنا وأعيت أجسادنا وعقولنا.
ولأن هذه النفقات تمثل المدخل العملي لفهم الأزمة، فإننا نستعرض شيئا منها لا من باب الإطالة أو التفصيل، بل لإظهار حجم الاستنزاف الذي فُرض على الناس قسرًا في حياتهم اليومية.
فإن بحثنا عن نفقاتنا والتزاماتنا الشهرية، ماذا نجد؟
نفقات المحروقات، سواء أكانت وقودا لمركبة تمتلكها، أم أجورا لوسائل المواصلات العامة أم غازا للطهي والتدفئة
نفقات الاتصالات والأنترنت سواء منها الثابتة في البيوت أم خدمات الهواتف المحمولة.
نفقات الكهرباء لكافة الاستخدامات، ونفقات المياه،
نفقات الصحة، سواء من خلال التأمين الحكومي (على فرض أن المستشفيات الحكومية توفر الرعاية الصحية الكاملة لجميع الأمراض وتتوفر فيها الأدوية اللازمة، وهذا مما يندر في بلادنا الإسلامية) أم من خلال التأمين عبر شركات التأمين الخاصة، أم مباشرة من المريض إلى المستشفيات الخاصة التي أصبحت تجارة رابحة في بلادنا.
نفقات التعليم، في المراحل الأساسية والثانوية، وقد يكون الأمر ميسورًا لمعظم الناس في حالة الالتحاق بالمدارس الحكومية، وصعبا على البعض في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في بلادنا، والبعض الآخر الذي قد يجد في دخله شيئًا يسيرًا من البحبوحة، فإنه قد يضيق على نفسه ويضحي بتلك البحبوحة لينفق مقابل التحاق أبنائه في مدارس خاصة لأجل بيئة تعليمية في ظروف أنسب، وذلك لما يُرى من اكتظاظ في صفوف المدارس الحكومية والإضرابات المتكررة، كما هو في فلسطين مثلا، بسبب تعثر السلطة الفلسطينية في دفع الرواتب–، ومن ثم لتبدأ رحلة جديدة من النفقات التي يعجز عنها الكثيرون عند انتقال الأبناء إلى الجامعات، ليضطر البعض منهم، بل الكثير لأن يلجأ إلى متبرع وراع هنا أو محسن ومانح هناك لتغطية نفقات ابنه أو ابنته في الجامعة حتى يتمكن أولئك الأبناء من إكمال دراستهم.
قائمة النفقات لا تتوقف هنا، بل تطول لتصبح أكبر وأكثر والأحمال كما يقولون تزيد ولا تنقص.
إن ما يعيشه الناس اليوم من ضنك في العيش وقلة ما في اليد ليس حدثًا طارئًا، ولا نتيجةً طبيعية لتقلّبات السوق كما يُروَّج، بل هو ثمرة مباشرة لانحراف خطير في مفهوم الدولة ووظائفها، وما يجب على الدولة أن تنهض به تجاه رعاياها، وكذلك انقلاب على الملكيات وحدودها، حتى تحولت موارد الأمة الأساسية إلى سلعة، بينما تم تسليم معادن الأرض وطاقتها ومياهها لشركات احتكارية تجني منها الأرباح.
إن الوقود الذي يُستخرج من أرض المسلمين ليس موردًا تجاريًا، والكهرباء والماء والغاز ليست خدمات استثمارية، بل هي ملكيات عامة لا يملك أحد أن يبيعها أو يفرض عليها رسومًا تُرهق الناس. أما الصحة والتعليم وتوفير الأمن ورعاية الشؤون عمومًا فهي من واجبات الدولة دون فرض رسوم أو ضرائب.
ومع ذلك، يُطالَب الناس اليوم بدفع أثمان ما لا يجوز أن يُباع بشكل تجاري مما هو ملك لهم أصلا، ويُكلفون بما لا تجب المسؤولية فيه عليهم مما هو واجب مستحق لهم أصلا، حتى باتت الأسرة في كثير من بلاد المسلمين تدفع من دخلها ما يجاوز نصفه على فواتير ونفقات هي في الأصل من حقوقها في الملكيات العامة، أو حقوقا لهم قصرت الدولة فيها، حيث تحولت الدول من وظيفة الرعاية إلى دور الجباية.
هذا هو ما قام به النظام الرأسمالي إذ حوّل ما هو في الأصل ملكية عامة للأمة أو ملكية الدولة لصالح الرعاية، إلى ملكية خاصة لأفراد وشركات، ثم أقام على هذا التحويل منظومة كاملة من الاحتكار والاستغلال.
والنتيجة المباشرة لذلك أن الناس حُرموا من الانتفاع الطبيعي بالملكيات العامة، والإرفاق بهم وبمصالحهم من ملكيات الدولة، فأصبح الوصول إلى الانتفاع والإرفاق مشروطًا بدفع أثمان مرهقة. فتحوّلت الطاقة، والماء، والوقود، والاتصالات، بل وحتى حقوق الصحة والتعليم، إلى سلع محتكرة، لا يحصل عليها الإنسان إلا بثمن يستهلك حياته وطاقته ومدخوله.
وبدل أن تكون هذه الملكيات العامة مصدر إرفاق بالناس وتخفيفًا عن كواهلهم، كما هي وظيفتها الطبيعية، انقلبت إلى عبء دائم في حياة البشر اليومية؛ فأصبحت سببًا لشقاء الشعوب لا لاستقرارها، وأداة استنزافٍ للمدخولات لا ضمانًا للعيش الكريم.
وكل ذلك التوحش الرأسمالي تُرجم إلى تضخّمٍ هائل في ثروات طبقة محددة أصبحت تملك الموارد، وتحتكر الخدمات، وتمسك بمفاصل الاقتصاد. ولم تقف الأمور عند حدّ الثراء، بل تجاوزته إلى النفوذ السياسي، حيث تحوّلت هذه الطبقات والشركات إلى قوة ترسم السياسات الداخلية والخارجية للدول، وتحدد أولوياتها، وتضغط على قراراتها، حتى باتت “السيادة” في كثير من البلدان خاضعة لمصالح رأس المال لا لمصالح الشعوب.
هكذا يعمل الوحش الرأسمالي، ينزع الملكيات من عموم الأمة، ثم يحوّلها إلى أدوات ربح خاص،
فالمسألة إذن هي النظام الاقتصادي برمته، بل قل النظام الذي يحكمنا وفق معايير ليست من الإسلام في جميع شؤون الحياة داخليا وخارجيا.
إن الحل ليس في دعمٍ مؤقت، ولا مبادرات تُهدّئ الغضب ثم تعود الأمور أشد مما كانت، بل الحل في ردّ الأمور إلى أصولها الشرعية:
إعادة الملكيات العامة إلى الأمة دون استثناء،
رفع يد الشركات والخصخصة عن الموارد التي هي من الملكيات العامة،
وتحمّل الدولة مسؤولية الرعاية كما فرضها الإسلام، لا كما تُمليه المؤسسات المالية أو تقتضيه السياسات الغريبة وتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
عندها فقط تنكشف حقيقة الأزمة، ويُرفع العبء عن الناس، وتستقيم المعيشة.
أما بغير هذا التصحيح الجذري، فسيبقى الناس يدفعون — كل شهر — ثمن الخلل، لا ثمن السلعة.
أ.صابر حسين
08/12/2025