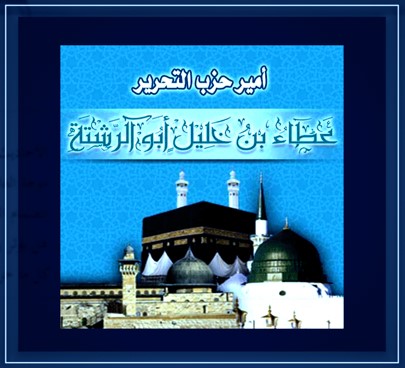لم يعد السفر عبر الجسر (معبر الكرامة) مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل صار رحلة شاقة مثقلة بالتعب والانتظار والإنهاك. مشهد الطوابير الطويلة، الساعات الضائعة، الوجوه المرهقة، الأطفال المتعبين،والنساء اللواتي يفترشن الأرض، وكبار السن الذين يطاردهم الألم قبل أن يطاردهم الطريق … كل ذلك بات صورة مألوفة لا تثير دهشة أحد، رغم قسوتها.
الناس في معظمهم وفي ظل هذه الظروف لا تسافر ترفًا، ولا تبحث عن متعة في هذه الرحلات القاسية. معظمهم يسافر مضطرًا: طالب يلحق بجامعته، مريض يبحث عن علاج، عامل يطارد رزقه، أو أسرة تحاول لمّ شملها بعد طول فراق، أو قاصداً لبيت الله الحرام، ومع ذلك يُستقبل هذا الاضطرار بمزيد من التضييق، وكأن المشقة وحدها لا تكفي.
ومن ناحية أخرى لم تعد كلفة السفر عبر الجسر نتيجة طبيعية للظروف فقط، بل باتت عبئًا يُفرض على الناس بصورة متراكمة ومنهكة. فقبل أن تطأ القدم الجسر، تكون الجيوب قد فُتحت قسرًا على مصاريف تتزايد بلا تفسير مقنع: أجور نقل ترتفع، رسوم تتعدد، وخدمات تُفرض وكأنها قدر لا مفرّ منه. وفي هذا المشهد، يبدو أن معاناة المسافرين تحوّلت إلى باب مفتوح لاستنزاف ما تبقى في جيوبهم، حيث تجد بعض الجهات في الأزمة فرصة لمكاسب مالية، تُحصَّل على حساب حاجات الناس وكرامتهم، في وقت يعجز فيه كثيرون عن تأمين أساسيات حياتهم اليومية.
المؤلم في الأمر أن المعاناة لا تقف عند المال والوقت، بل تمتد إلى الكرامة الإنسانية نفسها. الانتظار الطويل بلا اعتبار لظروف الناس، غياب الحد الأدنى من الرحمة، والتعامل مع البشر كأرقام أو ملفات عابرة… كل ذلك يترك جرحًا أعمق من التعب الجسدي.
ومع كل أزمة جديدة على الجسر، يتجدد السؤال الصامت في صدور الناس: إلى متى؟ إلى متى يبقى الانتقال بين بلدين، أو حتى مدينتين كانتا يومًا أرضًا واحدة، معركة يومية واختبار صبر لا ينتهي؟
وتزداد المفارقة قسوة حين يُستحضر ما سجّله التاريخ، كان المسافر ينتقل من الشام إلى العراق ثم إلى الحجاز في أرضٍ يعرف أنها أرضه، تحميه الدولة وترعاه،وعلى امتداد هذه الطرق أُقيمت الخانات والرباطات والنُزُل، فقد عرفت الدولة الإسلامية منذ العهد العباسي دروبًا مخصّصة للحجاج والمسافرين، أشهرها درب زبيدة من الكوفة إلى مكة، حيث موّلت زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد حفر الآبار وبناء البرك ومحطات الاستراحة على امتداد الطريق. وفي بلاد الشام وفلسطين، أُقيمت الخانات الرسمية مثل خان يونس وخان العمدان والخان الأحمر، بأوقافٍ ثابتة لإيواء المسافرين والحجاج ودوابهم وتوفير الماء والطعام لهم. واستمر هذا النهج في العهدين المملوكي والعثماني، حتى تُوّج في مطلع القرن العشرين بمشروع سكة الحديد الحجازية (1908) التي ربطت دمشق بالمدينة المنورة لتيسير الحج وخدمة الناس، بتمويل من تبرعات المسلمين أنفسهم.
لقد عرف المسلمون يومًا واقعًا مختلفًا؛ يوم كانت الأمة واحدة، يستظلون تحت ظل دولة واحدة، لا تمزقها الحدود ولا تعيقها المعابر. كان المسلم ينتقل من أقصى الأرض إلى أقصاها لا يخشى إلا الله، لا جواز يذله، ولا جسر يكسر روحه، ولا معبر يحاصره بالساعات، ذلك لم يكن حلمًا مستحيلًا، بل كان واقعًا عاشته الأمة حين كانت أمة واحدة.
إن هذا الواقع المرهق، وهذه الجسور المثقلة بالمعاناة، لن تكون قدرًا دائمًا. سينتهي هذا المشهد يوم تعود الأمة أمة واحدة، في دولة واحدة، تُصان فيها كرامة الإنسان، ويكون السفر فيها طريقًا لا عقوبة، وحقًا لا منّة، وأمنا لا خوفا، وهو كائنٌ بإذن الله، فكما صدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بأن تأتي الظعينة من الحيرة وتطوف ببيت الله الحرام لا تخشى أحداً في الطريق إلا الله وقد رأى ذلك عدي، سيصدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة الراشدة فتخرج الظعينة مرة أخرى لا تخشى أحدا في الطريق إلا الله، فهذا وعد غير مكذوب ونوشك أن نراه قريبا.
عبد الله النبالي
15/01/2026