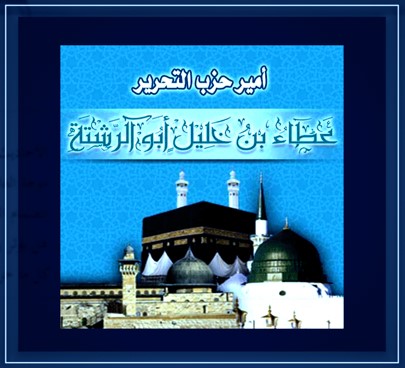من اللافت على منصّات التواصل الاجتماعي سيلُ التعليقات التي تتدفّق على هذا المصاب هنا في غزة، وذاك المصاب هناك في السودان، وقبله مسلمو الروهينغا في ميانمار، وبعده مسلمو الإيغور في تركستان الشرقية، وغيرها كثير من المصائب التي تتراكم على أمة الإسلام. تعليقاتٌ لا تكاد تخرج عن عبارات من قبيل: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، و«لا حول ولا قوة إلا بالله»، و«اللهم انصر المستضعفين»، و«اللهم عليك بالظالمين»، و«يا رب فرجك»، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».
ومن البدهي والمؤكَّد أنه لا إشكال في الدعاء ولا في الذكر، فالدعاء مخّ العبادة وعبادةٌ قلبية جليلة، غير أن كثافة هذه التعليقات على أيّة مصيبة، وغلبة الذكر والدعاء والحوْقلة عليها، تكشف عن خفايا مشكلة أعمق، وعن بوصلة يبدو أنها فقدت اتجاهها، إذ إن الدعاء في ميزان الشرع معينٌ على الفعل لا مسقطٌ للتكليف، ولا يقوم مقام الواجب إذا وُجدت القدرة وتعيّن العمل.
فعندما يغدو الدعاء اللغة الوحيدة التي تعرفها أمة الإسلام، وتتحوّل الحوقلة إلى شكل من أشكال التعبير عن الألم، وتصبح العبرات موقفًا كاملًا ونهائيًا، ثم يُغلق ملف المصيبة عند هذا الحد، ويُتخذ ذلك ذريعة لإخلاء المسؤولية وإرضاء النفس بأنها قد أدّت ما عليها، فهنا تكمن المصيبة فوق المصائب، والمشكلة فوق المشكلات، ويغدو العجز سيّد الموقف باختيارنا، متخذينه ستارا لترك ما أوجب الله علينا.
والناظر إلى هذا المشهد قد يظن أن المعلّقين على أخبار المصائب والمآسي التي تحلّ بالمسلمين، إنما يعلّقون على خبر وفاة شخص لا يمكن، بحال من الأحوال، إعادته إلى الحياة، فلا يملكون له إلا الدعاء بالرحمة والمغفرة، والاسترجاع بقولهم: «إنا لله وإنا إليه راجعون».
فهل يكتفي المعلّق، بذلك، عن عناء سؤال نفسه: ماذا يجب أن أفعل شرعًا، وما الذي يوجبه عليّ هذا الحدث من مسؤولية بحسب القدرة والاستطاعة؟ أم يعتقد أنه بتعليقه قد أخلى مسؤوليته وأبرأ ذمته؟ أم أننا بذلك نُسوّي بين مصيبة فردية تصيب أحدنا، وبين دماء تُسفك هنا وهناك، وأعراض تُنتهك، وأراضٍ تُغتصب، وكأن ما يحدث أمر لا قِبل لنا بدفعه، ولا مجال لتغييره، حتى وصلنا إلى حالٍ اختُزلت فيه قضايا أمتنا ودماؤها وأرضها في حزنٍ عابر، استدعينا فيه العبرات لتفريغ الغضب وإراحة النفوس؟
ويبدو أن تحوّلًا عميقًا قد طرأ على أفهامنا وثقافتنا أوصلنا إلى هذه الحال التي تتجلّى فيها معاني الاستسلام والخضوع للأمر الواقع. فمنذ أن قُسّمنا، وحكمنا الفرنسي والبريطاني والإيطالي حكمًا عسكريًا مباشرًا، ثم سُلّمت رقابنا لحكّام أعانوهم على إخضاعنا، وحفظوا سيطرتهم علينا، ونهبوا خيراتنا، وعملوا على حرف أفهامنا، وتغيير ثقافتنا ومناهج تعليمنا، وضرب كل فقه يرتبط بالسياسة والسلطان والعدل، ترسّخ هذا الواقع في الوعي العام.
وأدّى ذلك إلى أن استوطن العجز العقول، وخبا الإحساس بالظلم، وأصبحت قضية كل بلدٍ شأنًا خاصًا به، واقتصر واجب الشعوب الإسلامية في سائر البلاد على مجرّد التضامن، مع أن نصرة المظلومين في أصلها من فروض الكفايات التي إذا عُطّلت أو تُركت مع القدرة انقلب الإثم عامًا. حتى آل بنا الحال إلى الاكتفاء بالدعاء والذكر والاسترجاع في قضايا ومصائب ومآسٍ تستوجب بذل الأموال والأنفس، بل وتحريك الجيوش لنصرة المظلومين، وإقامة الدين، وردع المحتلين وأعوانهم.
فحين يُغلق ملف المصيبة بالدعاء وحده، وتُطوى الصفحة دون مراجعة أو محاسبة أو سعيٍ جادّ إلى التغيير، فإن الأمة لا تخسر معركة هنا أو هناك فحسب، بل تخسر قدرتها على الفعل، وتفرّط تدريجيًا في معنى وجودها، لتتحوّل من أمةٍ شاهدةٍ على الناس إلى أمةٍ تشهد على مآسيها ثم تمضي، وكأن الأمر لا يعنيها إلا بقدر ما يسمح به تعليق عابر، أو دمعة صادقة، أو تضامن لا يظهر فيه إلا معنى واحد، وهو أن ما يجري في بلدٍ آخر لا يعنينا.
وهذا كلّه على خلاف ما أمر الله سبحانه ورسوله ﷺ؛ فلم يكن في الإسلام يومًا أن يكون الدعاء بديلًا عن العمل، ولا أن يُتخذ الذكر ذريعة لإخلاء المسؤولية، بل إن القاعدة تقول: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب، وأن سقوط الواجب إنما يكون بالعجز الحقيقي لا بالعجز المتوهَّم. بل كان واضحًا عبر القرون أن التوكّل واجب، وأن الأخذ بالأسباب أعمال تُحقّق الأهداف، وأن الإيمان يتبعه عملٌ لتغيير الواقع، ولا يُقبل الاستسلام والركون بحجّة العجز أو القهر أو الاستبداد.
وفي السيرة النبوية تتجلّى هذه القاعدة بأوضح صورها؛ فالنبي ﷺ كان أكثر الناس دعاءً وذكرًا، لكنه في الوقت نفسه كان أكثرهم إعدادًا وتنظيمًا وتخطيطًا. ففي بدرٍ رفع يديه داعيًا حتى سقط رداؤه، لكنه لم يدخل المعركة بلا إعداد ولا تخطيط ولا شورى، فكان الدعاء، وكان العمل، وكان الأخذ بالأسباب. وعلى هذا النهج سار الصحابة والمسلمون، حتى في أبسط شؤون الدنيا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طلب الرزق: لا يقعدنّ أحدكم عن طلب الرزق يقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. وهذا صلاح الدين الأيوبي لم ينتظر معجزة من السماء والأمة يومئذٍ في حال فرقة وضعف، بل أعاد بناء الجبهة، ووحّد الصف، ثم استنصر بالله آخذاً بالأسباب.
وخلاصة الأمر أنه لا إشكال في الحوقلة ولا في الدعاء ولا في الذكر، وإنما الإشكال في أن تُفرَّغ من معناها الحقيقي، وأن تُوضَع في غير موضعها، وأن تُستعمل ستارًا للهروب من الواجب، فيُسوّى بين البلاء الذي يُسترجع عنده، والظلم والاحتلال والقتل والنهب والفرقة الذي يوجب الشرع فيها على الأمة أن تتحرك بكل طاقاتها لتغييره. فإذا وعينا ما أوجب الله علينا، ووضعنا الدعاء موضعه والعمل موضعه، عندها فقط يمكن للأمة أن تبدأ بكتابة تاريخها من جديد، وأن تصنع مستقبل الأجيال القادمة على بصيرة.
أ. صابر حسين
22/12/2025