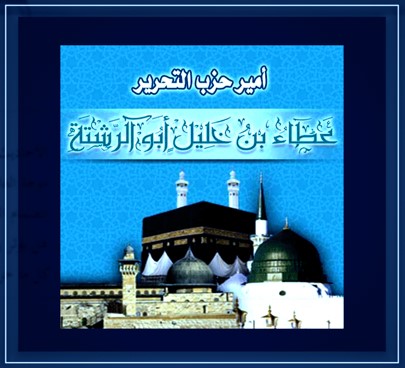يُستخدم مصطلح الغرب في كثير من الأحيان عند الحديث عن الاستعمار والحروب والدمار في العالم، وعند الإشارة للجهة المسؤولة عن الانحلال الأخلاقي تحت مظلة الحريات، والتفكك الاجتماعي، وتدمير الأسرة، وتراجع الإنجاب تحت عنوان المساواة، والتيه الفكري والإلحاد بدعوى تقديس العقل وإطلاق العنان له في الفلسفة والإلحاد، وغيرها من الكوارث التي سببها الغرب للبشرية، وربط ذلك بضرورة التصدي الفكري والسياسي له وهزيمته وإنهاء نفوذه والقضاء على وجوده؛ ولكن من الأهمية بمَكان إدراك أن المقصود بالغرب هو تلك الأنظمة الرأسمالية المطبَّقة في تلك الدول والوسط السياسي المشرف على عملية التطبيق ورسم السياسة الخارجية وفق وجهة نظر رأسمالية نفعية استعمارية وليس الشعوب التي تعيش في تلك البلاد، فالشعوب تُعرف بأنها مجموعة من الناس ينحدرون من أصل واحد؛ ولكنها أصبحت تطلق على الناس ضمن إطار وطني أو قومي يسمى حدود الدولة ولو كانوا من أجناس مختلفة، وفي الغرب تُحكم تلك الشعوب بالأنظمة الرأسمالية ولكنها بالطبع ليست النظام، وليست الدولة، وليست المبدأ، وليست الغرب الذي هو محل العداء والصراع.
وتلك الأنظمة وإن كانت تنسجم نسبيًّا مع الفكر الذي تحمله تلك الشعوب وما نتج عنه من مفاهيم ومقاييس وقناعات تمخَّضت عبر قرون من الصراعات الفكرية والسياسية والكنسية في أوروبا حتى تشكلت تلك الرؤية الحضارية العلمانية الرأسمالية الغربية لإسعاد الإنسان الغربي وتحريره من السلطة الكهنوتية التي استعبدته وأغرقت أوروبا بظلام العصور الوسطى، وهذه الغاية كانت العنوان الذي اتخذه المنظرون والمفكرون للترويج للمبدأ وعقيدته، إلا أن المبدأ بطبيعته الفكرية المتأثرة بردة الفعل دون عمق واستنارة وحقيقته البشرية الناقصة والعاجزة ورأسماليته الجشعة وكنتيجة منطقية لإحسان تطبيقه؛ وصل لمرحلة بات يَستغل ويَستعبد تلك الشعوب لصالح الرأسماليين والمتنفذين، وأصبح يتلاعب بهم ويسبب لهم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية؛ حتى باتت تلك الشعوب في شقاء وتعاسة، وباتت تلاحظ أنها مجرد أداة لخدمة المبدأ الرأسمالي والرأسماليين وأصحاب النفوذ المالية والسياسية، وأصبحت في حالة اضطراب مع فقدانها شيئًا فشيئًا للرفاهية والكماليات التي كانت ترقع وتستر كوارث النظام وإفرازاته وتُسْكر الشعوب عن حقيقته الفكرية المخالفة للفطرة وغير المقنعة للعقل وحقيقته السياسية الكارثية على البشر وحياتهم! وأصبح المبدأ محل تساؤل وشك، وتحول النظام لمصدر غضب واحتقان وعدم ثقة عند تلك الشعوب التعيسة التي باتت ضحية مثل غيرها من شعوب العالم، وأصبحت بحاجة إلى من ينقذها من براثن الرأسمالية، وما شهدته أوروبا من اضطرابات شعبية في العقود الأخيرة يعبر عن ذلك، وسوف نحاول في هذه المقالة التركيز على التفريق بين الأنظمة الحاكمة في الغرب والشعوب الغربية وكيف تكون النظرة الفكرية السياسية الصحيحة لتلك الشعوب.
فالشعوب الغربية حالها حال أي شعب عبارة عن أرض بشرية خصبة للأفكار والمبادئ والعقائد، ومخاطبتها تكون بالحجة والبرهان والإقناع العقلي، وما حصل في الغرب أن تلك الشعوب سحقت لقرون طويلة تحت راية كنسية ظالمة تتستر بديانة محرفة محدودة جدًا في تشريعاتها وعاجزة عن تنظيم شؤون الفرد والدولة والمجتمع، اتخذتها الكنيسة أداة لترسيخ الحكم “البابوي” الكهنوتي صاحب السيادة المطلقة والسلطة الوحيدة المهيمنة على الحياة والإنسان والمجتمع والدولة بما ينسجم مع مصالح رجالات الدين وهرطقاتهم؛ ما تسبب بحالة من الظلم والاستعباد والتخلف والاستغلال ونهب الأموال باسم الدين، وقد كانوا حريصين في حماية تسلطهم ونفوذهم بمحاربة العلم وقتل العلماء وتحقير العقل وسحق أي شيء قد يجعل الناس تفكِّر وتتمرَّد على خرافاتهم القائمة على الدجل وهرطقاتهم المبنية على الوهم، والتي حوَّلت أوروبا إلى جحيم يغوص في بحر من الظلمات، عوضًا عن عدم قدرتهم بنصوصهم الكهنوتية المحدودة والمحرَّفة على رعاية شؤون الناس وإدارة شؤون الدولة، فكانت تلك الشعوب الغربية المظلومة تبحث عن المخلِّص، وكانت هذه فرصة ذهبيَّة للأمة الإسلامية صاحبة الرسالة السماوية النقية الصافية المقنعة للعقل والموافقة للفطرة والتي ينبثق عنها نظام كامل وشامل يحقق الطمأنينة والعيش الكريم للإنسان بوصفه إنسانًا كرَّمه الله بالعقل والإدراك وجعل الإيمان من خلاله، وكذلك التسليم بما جاء به الوحي من نظام كامل وشامل من الخالق العَالِم بالإنسان وما يصلح له؛ ولكن الأمة الإسلامية ممثلة بدولتها في ذلك الوقت لم تحسن استغلال تلك الفرصة خاصة في أوروبا الغربية لأسباب متعلقة بالمسلمين وأخرى متعلقة بالتصدي الكنسي الصليبي القوي للدولة الإسلامية ومنعها من الوصول للشعوب الأوروبية، كما حصل في عهد الخلافة العثمانية عندما توحَّدت أوروبا لمواجهة الفتح الإسلامي فيما عُرف عندهم بالمسألة الشرقية، خاصة بعد أن فتح المسلمون المجر والنمسا ووقفوا على أسوار فينا، إضافة إلى نشر الكنيسة للإشاعات وممارسة التضليل على الشعوب الغربية وتشويه الإسلام بنظرها؛ لتتخذ من الإسلام العدو اللدود لها كما حصل في الحروب الصليبية، فوُجد في الغرب نتيجة ذلك الواقع السيئ تحت حكم الكنيسة ورجالات الإقطاع إحساس بالظلم أنتج حركة فكرية سُمِّيت بالحركة التنويرية والحداثية مع نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر؛ وذلك بدافع تخليص الناس مما هم فيه من ظلم وسوء عيش.
تلك الحركة الفكرية الساعية للتحرر من الكنيسة وسلطتها الدينية، والقائمة على تقديس العقل كردة فعل لما كان من هرطقات سابقة وإطلاق العنان له دون قيد أو شرط، تحوَّلت إلى عقيدة علمانية أفرزت مبدأً لتنظيم شؤون الحياة عرف بالمبدأ الرأسمالي، وأنتجت حضارةً غربية تمثلها مجموعة مفاهيم عن الحياة وثقافةً غربية تتضمن مجموعة من المعارف، طبعًا كلها منضبطة بوجهة النظر العلمانية “اللائكية” عن الحياة، والتي على أساسها كانت تلك النهضة في أوروبا بعد أن تفاعلت الشعوب الأوروبية التي تبحث عن المخلص مع تلك الحركة الفكرية السياسية التي تُرجمت في النهاية إلى نهضة مبدئية وصناعية انبهرت بها الشعوب الغربية فتلقت الفكر الغربي بكل ما يحتويه وأصبحت تدافع عنه، فهو بنظرها المنقذ والمخلص من ظلم الماضي وذلك دون أن تدرك خطأه المبدئي وكوارثه المستقبلية وانحرافاته الفكرية وعقيدته المشوَّهة، ودون أن تدرك أنها انتقلت من أنياب الكنيسة إلى مخالب الرأسمالية التي لا تقل إجرامًا عن سلطات العصور الوسطى ورهبانها ورجالات إقطاعها وأصبحت تلك الشعوب إحدى ضحايا المبدأ الرأسمالي والأنظمة التي تطبقه.
وباستعراض تلك الحقائق نجد أن الشعوب الغربية هي ضحية سابقًا للكنيسة والإقطاع ومن ثم للتنوير والعلمنة والإلحاد والفكر الرأسمالي المبرمج في طبيعته لخدمة فئة من البشر وهم أصحاب النفوذ المالي والثروات، وأن تلك الشعوب يتم خداعها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية… وأن تلك الشعوب بحاجة إلى من يوضِّح لها أن نهضتها كانت على أساس فكري خاطئ تأثر بردة الفعل على عصور الظلام، وأن عصورها الظلماء الكهنوتية ليست حجة على الإسلام حتى تكون مدعاة لرفضه، وأن التفكير العقلي المستنير يُظهر أن البشر بحاجة إلى نظام ينظم شؤون حياتهم ويصلح لكل إنسان ومجتمع ودولة ولكل زمان ومكان، وأن هذا النظام لا بد من أن يكون من عند جهة لا محدودة وغير ناقصة وغير محتاجة، أي من عند من خلق البشر ويعلم ما يصلح حالهم وينظم شؤونهم، أي أنه لا بد من أن يكون بوحي من السماء ورسول ورسالة واضحة وعملية في رعاية شؤون البشر، وأن جعل الدليل العقلي هو أساس البرهان على صحة تلك الرسالة، وأن احترام العقل لا يعني تقديس العقل وجعله غير محدود ويبحث فيما يدرك حِسه وواقعه وما لا يدرك، بل وجعله بمنزلة الإله الذي يُعبد، وهذا الصراع الفكري يكون على مستوى الأفراد والجماعات كما هو حاصل حاليًّا ويكون على مستوى الدولة التي تجسِّد مبدأ يمثل البديل لتلك الشعوب وتحمله إليهم.
إن الظروف والرياح لا تسير بما تشتهي الحضارة الغربية حاليًّا، فهي إن تمكنت من إخفاء أن حضارتها التي أنتجت الثورة الصناعية هي التي تسببت في الحروب العالمية التي أحرقت أوروبا وقتلت ملايين البشر، وأن مفاهيمها التي أخرجت الإنسان من مستنقع الجهل والهرطقة هي التي أسقطته في وحل اللذة والهوس بالجنس والمخدرات، وأن عقيدتها التي أراحت الناس من قسيس كاذب يبيع أراضيَ في الجنة هي التي جعلته يقتل نفسه بسبب الخواء الروحي والاضطراب الفطري والنفسي، وأن دولها التي وفرت لها مستوًى عاليًا من العيش هي في الحقيقة توفر لها ذلك من خلال سرقة ونهب ثروات الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث… فهي إن استطاعت أن تخفي ذلك، ولكن هل تستطيع إخفاء “إنسانيتها” التي دعمت كيان يهود في إبادته لأهل قطاع غزة؟ وهل تستطيع إخفاء حقيقة مفاهيمها البرَّاقة عن حقوق الإنسان وتجريم الإبادة بعد أن لطختها دماء الأطفال والنساء والشيوخ…؟ وهل بإمكانها الدفاع عن قداسة مؤسساتها الدولية التي ساوت بين الضحية والجلاد والتنظير على العالم وخداعه باسم الديمقراطية والحرية، وقد ظهر أنها أم الاستبداد والاستعمار وأبوه؟ وهذا ما يدفع للقول بأن الحضارة الغربية تنعى نفسها، وأن هذه الأحداث تسرع في انكشافها وانفضاحها حتى عند أهلها.
وفي الختام، لا بد لنا كمسلمين من إدراك الفرق بين الأنظمة الحاكمة في الغرب والتي لها سياساتها التوسعية الاستعمارية، ولها أهدافها الاستراتيجية الخطيرة التي تدوس في سبيلها على القيم وتشعل لأجلها الحروب وتصنع الفقر وهو ما يوجب على الأمة الإسلامية اتخاذ حالة العداء التام معها والسعي لإقامة الدولة القادرة على سحقها سياسيًّا وعسكريًّا وفكريًّا، وبين الشعوب الغربية التي تستغلها تلك الأنظمة الرأسمالية لمصلحة تلك الطبقة الغنية المتنفِّذة وتوهمها أنها تشارك في الحكم والتشريع وتؤثر عليها بالخداع وتشويه الحقائق… وإدراك أن انكشاف ذلك للشعوب الغربية كما يحصل الآن ينعكس بشكل مباشر على نظرتها واحترامها للمبدأ وثقتها بالنظام ككل وعلى سلوكها تجاه الأنظمة، وهذا ما رأيناه من انخلاعهم عن حكامهم والتظاهر ضدهم بسبب سياساتهم وتصريحاتهم المؤيِّدة لـ(إسرائيل) وهذا يمثل فرصة حضارية ذهبية للأمة الإسلامية لتنهض وتقيم دولة الخلافة الراشدة التي تحرك الجيوش وتكسر الحواجز وتحمل رسالة الإسلام لشعوب العالم أجمع.
وهذا التفريق بين الأنظمة والشعوب نرى أن الإسلام قد أخذه في الاعتبار في سياسته الخارجية في الدعوة والجهاد؛ إذ فرَّق بين الحكام والشعوب، واعتبر الحكام هم الحاجز المادي الذي يحول دون الوصول إلى دعوة الشعوب وقبول الإسلام بكل حرية، فكانت إزالة هذا الحاجز إنما تكون عن طريق الجهاد ضد الحكام وجيوشهم التابعين لهم؛ حتى إذا أزيل هذا الحاجز وفتح المسلمون البلاد دخل الجيش الإسلامي إلى البلد ودخل معه المسلمون والدعاة والعلماء، وطبق الإسلام بالسوية دون إجحاف أو ميل؛ ليكون ذلك دافعًا لهم ليؤمنوا به عن قناعة لا عن إكراه.
د. إبراهيم التميمي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير الأرض المباركة (فلسطين)
26/3/2024