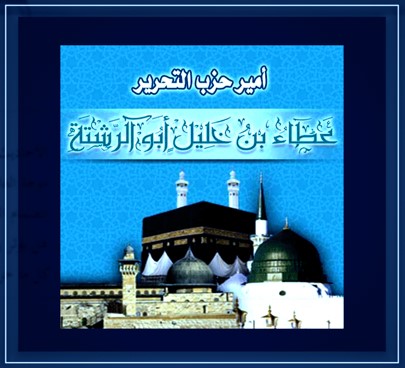بقلم: يوسف أبو زر
في مقال له في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 21 كانون ثاني 2022، وتحت عنوان "تصور عام لطبيعة الدولة الدينية" تناول الكاتب عبد الغني سلامة تصوراته لشكل وطبيعة الحياة في ظل الدولة الإسلامية في حال إقامتها.
وقد بدأ الكاتب بمقدمة أشار فيها إلى تجاوزه لمسألة وجوب إقامة الدولة الإسلامية من حيث كونها فريضة شرعية أو اجتهادا فقهيا، أم هو مطلب لأحزاب تسعى للظفر بالسلطة، حيث أنها مسالة غير محسومة داخل "المؤسسة الدينية" في نظره، وذلك تجاوزا إلى ما يهمه في المقال وهو تخيل شكل وطبيعة الحياة في حال وجودها،
ينتقل الكاتب إلى وصف الدولة الإسلامية بحسب "مفاهيم علم الاجتماع السياسي" بأن معناها هو الدولة الدينية، حيث يحكم رجال الدين حسب أيديولوجية الحزب الحاكم، وبالتالي قداسة الحاكم الذي لا تجوز مخالفته كون سلطته مستمدة من الله وحيث لا مخالفة لحكومته، مع إقرار الكاتب -وفي جملة تناقضية -إلى أن أدبيات الإسلام السياسي تقر بوجوب مخالفة الخليفة عند مخالفة الدين والمعصية.
ويتابع حديثه بأن هذه الدولة قد تتحول إلى نظام طائفي وذلك بالنظر إلى كون الخليفة يجمع بين "السلطتين الزمنية والروحية" الواجبتا الطاعة، والعابرتان للحدود والقوميات وفوق الطوائف، مما سيوجد إشكالا في التعامل مع الطوائف الأخرى، حيث يقوم كل ذلك على إخضاع الطوائف الأخرى والتي يراها عملية مستحيلة، كحالة السنة والشيعة في ظل الشحن الطائفي كما في الواقع الحالي، عوضا عن الطوائف الأخرى من غير المسلمين سواء كتابية أو غير كتابية.
ويرى كذلك أن الدولة الدينية سينتج عنها مجتمع ديني، ومع أن كل فرد هو منتم لطائفة إلا أن التعايش ممكن، غير أنه مع سيادة النزعة الدينية سيضعف التعايش وتتعزز الطائفية.
ويشير الكاتب إلى أنه مع أن دستور الدولة الإسلامية (كما يقترحه حزب التحرير) ينص على انه لا يجوز أن يكون لدى الدولة الإسلامية تمييز من ناحية الحكم والقضاء ورعاية الشؤون، بل يجب النظر للجميع بنظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الدين أو غير ذلك، إلا انه يرى بأن الإشكال أن الدولة لا تعطيهم نفس الحقوق الممنوحة للمسلمين، وكمثال على ذلك حقوق تولي الخلافة وبعض المناصب، وأن القيم الإسلامية وإن كانت تحتوي على التسامح، ولكن الدولة لا تتعامل بمنطق التسامح بل بمنطق المواطنة والحقوق، وليس بمنطق التسامح كمنحة من أكثرية لأقلية.
وأخيرا، يستنتج الكاتب أن تجارب التاريخ تشير إلى تحول الدولة الدينية إلى مستبدة تقودها منظومة أمنية، تخضع من هم خارج طائفة الحزب الحاكم، وتضرب كل من يخرج على الإجماع، حيث لا رأي مخالف ولا حرية ولا تعددية، وحرية شخصية مقيدة بفقه القرن الثاني الهجري، ويخلص إلى أن هذا ما حدث بدول الخلافة السابقة، فلماذا سنفترض أن الخلافة المنشودة ستكون مختلفة عن تجارب 1400 سنة؟
ومع أن المقالة –وقد حاولنا اختصارها باقتباس أبرز الأفكار فيها- هي عبارة عن مزيج من تصورات الكاتب وخياله للواقع في ظل الدولة الإسلامية حال قيامها، إلا أن هذه التصورات تقوم على مجموعة من المغالطات والمقدمات الخاطئة التي أنتجت تشوهات كبيرة في التصور، حيث استلهم الكاتب نموذجه النظري للدولة "الدينية" من تاريخ أوروبا مسقطا له على واقع الدولة في الإسلام، بالرغم من التناقض بينهما، وبحيث أنه عرف الدولة الإسلامية بتعريف "علم الاجتماع السياسي" للدولة الثيوقراطية الأوروبية دون العودة لواقع الدولة والحكم في الإسلام وفكره وفقهه وحتى تاريخه، بالإضافة إلى شيء من الترحيل للإشكاليات التي نشأت في بيئة الدولة العلمانية القطرية وافتراضها في بيئة الحكم الإسلامي.
وقد قمنا بالرد على مضمون المقالة وبإجمال شديد احترازا للإطالة بالنقاط التالية:
* إن وجود الدولة الإسلامية أمر بدهي في الإسلام، ووجوب إقامتها إن لم تكن موجودة إنما هو إقامة للدين، وهو أمر محسوم في الشريعة، بل مقطوع به، حيث فرض الله عز وجل في كتابه الحكم بما أنزل الله، وأشارت الآيات إلى ولاة الأمر في معرض الطاعة، وشرعت الأحكام التي لا توجد إلا بسلطة تطبقها، وقد أقام الرسول عليه الصلاة والسلام دولة للإسلام، تولاها من بعده الخلفاء، وقد جاءت أحكام الشريعة مفصلة لنظام الحكم في الإسلام، وهو نظام فريد متميز يتمثل في الخلافة التي استمرت ثلاثة عشر قرنا قبل أن تهدم دولة الإسلام، عاش في ظلها المسلمون واتفق علماؤهم على وجوبها، وإن عدم وجود الدولة الإسلامية كفكرة جوهرية في برامج بعض الحركات الإسلامية لا يعني عدم وجوبها بل يعني شدة القصور والإخفاق في برامج تلك الحركات.
* نعم إن الإسلام دين، ولكنه دين موحى به من عند الله عز وجل، وبخلاف الأديان فإن الإسلام لا يقتصر على النواحي الروحية، بل هو يعطي التصور الصحيح عن هذه الدنيا وعلاقتها بالله، وله كذلك طراز فريد في الحكم والتشريع، ونظام صحيح ينظم شؤون الحياة كلها للإنسان وللمجتمع، يعالج المشكلات ويحل الأزمات وتطبقه الدولة.
* الدولة الإسلامية، وعلى النقيض التام من نموذج " الدولة الدينية" كما يتصوره الكاتب، والذي كان سائدا في أوروبا، إنما هي دولة إسلامية لأن نظامها في الحكم والتشريع هو الإسلام، بحيث أن السلطان فيها هو للأمة، والحاكم يأخذ سلطانه من الأمة إذ تنيبه عنها لتطبيق الشرع، ولا يصبح المرشح للحكم خليفة إلا ببيعة الناس له على إقامة الشرع، واستمراره في منصبه متوقف على استمرار تطبيق نظام الإسلام، وطاعته كذلك، وليس له أية قداسة مطلقا، إذ تحاسبه الأمة على التطبيق وعلى إحسان التطبيق، وهذا الأمر حق من حقوقها وواجب من واجباتها، فالأمر كله هو حاكم سلطته في تطبيق نظام الإسلام وسياسة الرعية على أساسه.
ولا وجود في الإسلام لما يسمى بالسلطة الزمنية أو السلطة الروحية، كما أنه لا وجود لمفهوم رجال الدين ولا لحكم رجال الدين.
* عند تطبيق أي نظام، فإنه لضمان تطبيقه يجب أن تطبقه سلطة، والخضوع من قبل الناس للدستور والنظام هو أمر طبيعي في كل الدول في الدنيا مهما كانت تنوعات الناس وطوائفهم في ذلك المجتمع، بل لأجل هذا الأمر تحديدا تلزم النظم، ووجود الطوائف والاختلافات لا يعني غياب النظام، فهذا ما لا يقول به عاقل، وكذلك نظام الإسلام فإنه يطبق في دولة الإسلام على جميع الناس مع ضرورة خضوع الجميع للنظام أو كما يعبر عنه حديثا بـ " سيادة القانون" ، وإننا نرى أن كل الدول التي تعيش فيها أقليات وطوائف تكون تلك الطوائف مطالبة باحترام النظام العام والدستور الذي تعيش في ظله.
والسؤال هنا، هل الإشكاليات التي تطرح حول طرح نظام الإسلام للتطبيق هي لمجرد أنه "الإسلام" أم لأنه "دين" أم لكليهما؟؟!! مع التذكير هنا أن موضوع الحديث إنما هو عن البلدان الإسلامية وعن مجتمعات التي هي في غالبيتها الساحقة من المسلمين التواقين إلى تطبيق شريعة ربهم.
* على أن الفارق بين نظام الإسلام والأنظمة الأخرى هو أن نظام الإسلام وتشريعه إنما هو بطبيعته وحي من الله عز وجل، خالق البشر جميعا، فهو ليس نظاما وضعته فئة من الناس ولا طائفة من الطوائف ولا رجال دين، ولذلك فهو نظام كامل، يتحقق فيه العدل للجميع، بل لا يتصور العدل خارجه )وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(، وبالتالي فلا يتصور فيه كنظام وجود الظلم لا للمسلمين ولا لغير المسلمين، أما بالنسبة للمسلمين على اختلاف مذاهبهم فإنهم متفقون على الإسلام وقطعياته وعلى ضرورة سيادة شريعته، وأما غير المسلمين فهم في حق الرعاية والانتصاف وأمام تطبيق النظام العام سواء، لهم أديانهم وعقائدهم يمارسونها دون إكراه.
* لم يتعامل الإسلام مع الأقليات بوصفها "أقليات"، بل تعامل معها كشرائح في المجتمع ومن الرعية ولها في الشرع أحكامها المتعلقة بها، فلا يوجد قضية في الدولة الإسلامية تسمى "الأقليات" ولا مفهوم "الأقليات" ولا "حقوق الأقليات" والتي تشعرهم دوما بانفصالهم عن بقية الرعية، ولعل تاريخ المسلمين وعيش مختلف الطوائف والملل، الكتابية منها وغير الكتابية في المجتمع الإسلامي خير دليل على ذلك، ولو كان التاريخ كالحاضر لانقرضت تلك الأقليات هجرة وفناء.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عدم جواز أن يتولى غير المسلمين الخلافة لا يعني انتقاص حقوقهم، بل هذا منطق عجيب، إذ أن تطبيق النظام وضمان إحسان تطبيقه لا يكون إلا لمن يحمل فكرة النظام وعقيدته ويدين بالإسلام، وهذا لا يتصور من غير المسلم، وإلا فكيف يتصور أن يطبق أحد ما نظاما ليس له قناعة به بل ويعتقد غيره، على أن الإسلام ليس فقط نظاما لحياة الناس وشؤونهم وإصلاح دنياهم، وإنما هو كذلك دين نتعبد الله كمسلمين بإعلاء كلمته وإقامة أحكامه لصلاح الآخرة، ولذلك لم يجعل الشرع لهذا الأمر إلا لأهله.
وأخيرا،
فإن الدول المستبدة التي تقودها منظومات أمنية تمارس القمع لحساب الحاكم والحزب الحاكم، هو الواقع الصارخ للأنظمة الحالية، وهي أنظمة الدول القطرية العلمانية، لا كما يفترضها الكاتب واقعا في الدولة الإسلامية حال قيامها، وهي واقع الحال في الأنظمة التي استجلبت كل الأزمات عندما طبقت أنظمة رأسمالية غربية غريبة، فظلمت وقمعت ومارست جرائمها بحق الجميع، وخاصة بحق الأمة وأبنائها حين حاربتهم في دينهم وحالت بينهم وبين تطبيق شريعة ربهم، وورطت "الأقليات" بمؤامراتها القذرة الإجرامية فأنتجت ما نراه من توحش للطوائف، وكل ذلك في واقع موجود لا في خيال مفترض.
ومن هنا، فإن الدولة الإسلامية المنشودة التي نسعى لقيامها، والقائمة قريبا بإذن الله، هي المعول عليها في الخلاص من هذا الواقع البائس للأنظمة العلمانية المجرمة في بلاد المسلمين، وإن الوحي الذي نزل من عند الله عز وجل في القرن الهجري الأول وقبله، هو الأمل في خلاص البشرية من أزماتها، وارتقائها من وحل الانتكاس حتى في الفطرة، وإنقاذها من التخلف العلماني والتوحش الرأسمالي برسالة الرحمة للعالمين.