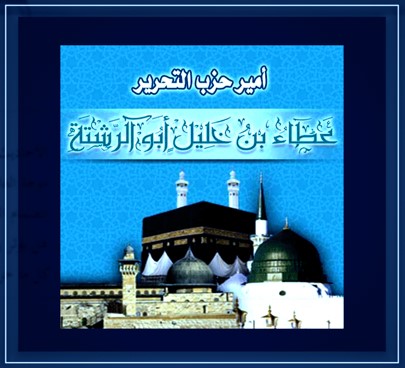القوة العسكرية والتغيير السياسي
الدكتور ماهر الجعبري – عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين
 إن حالة تبدل الأنظمة السياسية كما حصل بعد الانقلاب العسكري في مصر، وكما تضمنت دعوة بعض الجهات المنتسبة للثورة في الشام للتدخل الأمريكي، وكما حصل فيما سبقها من تدخل حلف النيتو في التغيير السياسي في ليبيا، يستدعي وقفة سياسية -فكرية وشرعية- أمام دور وحدود القوة العسكرية في تغيير الأنظمة.
إن حالة تبدل الأنظمة السياسية كما حصل بعد الانقلاب العسكري في مصر، وكما تضمنت دعوة بعض الجهات المنتسبة للثورة في الشام للتدخل الأمريكي، وكما حصل فيما سبقها من تدخل حلف النيتو في التغيير السياسي في ليبيا، يستدعي وقفة سياسية -فكرية وشرعية- أمام دور وحدود القوة العسكرية في تغيير الأنظمة.
بداية يلاحظ المفكر السياسي أن مراجعة نماذج بناء الدول عبر التاريخ ظلّت دائما مستندة إلى تأمين قوة غالبة ترعى نشأة تلك الكيانات، وتؤمن حمايتها من الارتداد عليها داخليا من خلال حركات التمرد، ومن العدوان عليها خارجيا بالغزو والاحتلال.
ولقد أرجع بعض المؤرخين تلك القوة العسكرية إلى "العصبية"، وذلك حسب واقع "القوة" في الشعوب القديمة، كما فعل ابن خلدون –رحمه الله- في مقدمته (الطبعة الأولى 1993-دار الكتب العلمية بيروت)، حيث اعتبر ابن خلدون "أن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه" (ص 110)، ولذلك خلص إلى أنه "إذ حصل التغلّب بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التغلّب على أهل عصبية أخرى... فإن أدركت الدولة في هرمها ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة أهل العصبيات استولت عليها وانتزعت الأمر من يدها، وصار الملك أجمع لها..." (ص 110). وأكد أن "الملك والدولة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية" (ص122).
أما في الزمن المعاصر، فقد تحولت القوة العسكرية عن "العصبية" التي تأتمر برؤوس القبائل من رجالها، إلى الجيوش النظامية التي تأتمر بقادتها وجنرالاتها، وقد تتمثل أحيانا في فصائل وكتائب تلتف وتتسلح لأجل غاية سياسية، وتحت قيادة عسكرية محددة، ولكن قدرتها على حسم الأمر يتعلق بميزان قوتها العسكري في مقابل قوة الدولة المتغلبة.
إذن لا يمكن إحداث تغيير سياسي فعلي يبدّل الدول، بلا قوة توفر "الحماية والمدافعة والمطالبة" لرجال الدولة الجدد ولنظامهم السياسي. ولا زال وصف ابن خلدون لغياب هذا المفهوم عن العامة في محله عندما قال "وهذا الأمر بعيد عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون له، لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أولها..." (ص 122).
ومع ثبوت هذه الحقيقة من أنه لا تقام دولة على أنقاض دولة أخرى إلا بتوفر قوة عسكرية تنصر كيان الدولة الجديد، فإن من المشاهد الملموس انه قد يحدث "تغيير سياسي" في بعض الدول دون قوة عسكرية تحميه، ولكن التبصر في واقع ذلك "التغيير" يفضي إلى أنه في الحقيقة لا يعدو "التعديل السياسي" أو "الإصلاح" الجزئي، ولا يكون تغييرا جذريا يخلع النظام السابق وينشئ نظاما جديدا. وهو ما تفتح الأنظمة الديمقراطية نوافذه الجزئية، إلا أنها (الديمقراطية) تغلق المنافذ أمام ما تسميه "دعوات التغيير الشمولي"، الذي يخلع النظام الديمقراطي من جذوره ويستبدل به نظاما آخر.
هذا من حيث الركن الأول في بناء الدول: ولكنّ توفر القوة العسكرية لتحقيق غاية تغيير سياسي أو بناء دولة لا يمكن أن تحقق استقرارا سياسيا جديدا إن لم يتوافق هيمنة تلك القوة على المجتمع مع هيمنة فكرة سياسية يحملها المجتمع ويسعى لتطبيقها (بغض النظر عن صحة تلك الفكرة وأحقيّتها). وهذا ما يشهد عليه الواقع المصري بعد الانقلاب. أي أن نشأة الدولة واستقرارها يقتضي قوة عسكرية مع قوة فكرية-سياسية (وهو الركن الثاني إن لم نقل الأول من حيث الأولوية).
ولذلك يمكن تلخيص معادلة التغيير السياسي بأنها التحام بين فكرة ظاهرة (في مجتمع ما) مع قوة ناصرة (تحميها). فالفكرة السياسية بلا قوة لا تؤدي إلى دولة، والقوة بدون فكرة (أو دعوة) لا يكتمل فيها نضوج الدولة وتمكّنها واستقرارها، ولذلك اعتبر ابن خلدون "أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها" (ص 125).
وهذا التلخيص لمعادلة التغيير يكاد يكون حقيقة تاريخية يشهد عليها تداول الأيام بين الناس في التاريخ، كما تشهد عليها تجارب التغيير السياسي المعاصرة في الواقع الثوري للأمة.
كما تشهد عليها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في بناء دولة المدينة استنادا إلى قوة أهلها ونصرتهم، وهم الذين حملوا اسم الأنصار تأكيدا على وصف تلك الحالة من النصرة لإقامة الدولة، وتجسيدا لتلك الحقيقة الإسلامية، وذلك بعدما مكث فيهم مصعب بن عمير عاما يهيئ الأجواء بنشر العقيدة الإسلامية بين أهل المدينة، حتى تكون النصرة للفكرة الإسلامية لا لمجرد حماية شخص الرسول صلى الله عليه وسلم من بطش قريش، ولم يهاجر لتسلم الدولة إلا بعد اجتماع الفكرة الإسلامية مع قوة النصرة في المدينة.
وهذا ما يشهد عليه حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا الإيمان بالفكرة والنصرة بالقوة في الحرب التي تخوضها الدولة، وذلك بالقول "يا رسول الله, لقد آمنا بك وصدقناك, وشهدنا أن ما جئت به هو الحق, أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك, فامض بنا يا رسول الله لما أردت, فنحن معك, فو الذي بعثك بالحق, لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك, ما تخلف منا رجل واحد, وما يكره أن تلقى بنا عدوا غدا, وإنا لصبر في الحرب..." فهي نصرة دولة بالقوة في الحرب.
***
إن التغيير السياسي القائم على فكرة تناقض فكرة الدولة الحالية هو عملية صراع ومغالبة، تكون فكرية الطابع ثم متبوعة بحسم عسكري. وهذا الحسم يكون بانحياز أهل القوة العسكرية إلى الفكرة الجديدة وتبنيها لهم كمشروع سياسي، وهذا الانحياز العسكري لا يكون على أساس صفقة مصلحية كحال الانقلابات العسكرية التي لا تسند لفكرة تغيير يحملها المجتمع (مثل الانقلاب في مصر)، بل هو على أساس مبدئي يقتنع أهل القوة به في الوقت الذي يجدون فيه الاستعداد الفكري في المجتمع.
ولذلك فإن كانت القوة العسكرية التي تنصر الفكرة السياسية من وسط الأمة فهي نصرة طبيعية، لأن القوة والأمة هما من جنس الفكرة الواحدة (العقيدة الإسلامية)، كما هي الحال في جيوش المسلمين والأمة الإسلامية، فالجند هم أبناء الأمة ويحملون عقيدتها، ولذلك فنصرتهم لمشروع الأمة السياسي هي نصرة طبيعية، عندما يُستنهض فيهم دافع العقيدة وتتحرك فيهم بواعث الإيمان وتشحن هممهم للتغيير الذي يجلب الخير لأبنائهم وأحفادهم.
إما إن كانت القوة العسكرية أجنبية، فهي ليست نصرة على إطلاق، لأن الأجنبي يحمل مشروعا سياسيا مغايرا عن مشروع الأمة، وبالتالي فهو يعمل على توجه التغيير بما يتوافق مع مشروعه وما يحقق مصالحه، وهذا الحال مشاهد ملموس في "نصر!" النيتو للتغيير في ليبيا، حيث عمل على إنتاج نظام عربي متجدد: صحيح أنه قل فيه مستوى القمع والكبت، ولكنه لم يحدث تغييرا سياسيا جذريا، بل حافظ على تدفق النفط نحو الغرب، وجدد النفوذ الاستعماري عبر إعادة إنشاء طبقة سياسية من جنس الأنظمة العربية ذاتها. وهو أيضا إعادة إنتاج وقائع تاريخية مخزية، من مثل استنصار بعض ممالك الأندلس بقوى أوروبية ضد بعضها، واستنصار بعض ممالك الأيوبيين بالصليبين وعقد الصفقات معهم للتغلب في الدولة.
إذن، هنا نميز بين طلب النصرة من جيوش المسلمين التي تحمل العقيدة نفسها وتتحرك بدافعها، وبين الاستعانة بالأجنبي الذي يحمل عقيدة مغايرة (رأسمالية نفعية)، ويتحرك بدوافعه ومصالحه الاستعمارية، مما لا يمكن أن يكون "نصرة" ذاتية بل هو على الحقيقة هيمنة أجنبية. ولذلك لا يمكن وصف الاستعانة بالأجنبي في التغيير السياسي بأوصاف سياسية دون مستوى العمالة والخيانة، لأنها تمكين للمستعمر من رقاب الأمة وإخضاعها لهيمنته.
ولذلك أيضا فإن أي دعوة للتدخل الأجنبي (كتدخل أمريكا في الشام) هي استغباء سياسي وقح، ولو أطلقها أصحاب اللحى والعمائم، وهم بذلك يقفزون فوق حقائق التاريخ، ويتجاوزن أحكام التغيير التي سار فيها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يأمرون بالباطل من خلال رمي الثورة في حضن المستعمر، ويتعامون عن معروف طلب النصرة من الجيوش الإسلامية.
***
إن ما يجري في الشام يقتضي من الجيوش الإسلامية فعلين متقاربين في المسميات والوصف هما: نصرة للتغيير السياسي، ونصرا لرفع الظلم ورد العدوان الأسدي، والتصدي لعصاباته، وهما يقتضيان تدخل القوة العسكرية من الزاويتين المحددتين في الآيتين الكريمتين:
1) الآية الأولى حول نصرة الدعوة السياسية: "وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا"، التي تصف حال أنصار المدينة الذين نصروا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم (دعوة هداية وتغيير سياسي)، فمكنوه من إقامة الدولة وتغيير النظام السياسي الجاهلي. ولذلك فإن قيام دولة المدينة على هذا الأساس من نصرة أهل القوة للدعوة النبوية هو حكم شرعي قطعي –جاء بنص قطعي صريح- فلا يمكن لمن يقرّ بالقرآن أن يخالفه.
2) الآية الثانية حول الاستنصار في الحرب ضد الأعداء: "وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْفِيالدِّينِ فَعَلَيْكُمُالنَّصْرُ"، وهي توجب على القوة الإسلامية وجيوش المسلمين الدفاع عن المسلمين أمام أي عدوان يتعرضون له، وهذا النصر غير متوقف على وجود عملية تغيير سياسي. بل إن هذا الدفاع عن المسلمين واجب على أهل القوة العسكرية ضد كل احتلال غاشم، وضد تسلط كل نظام كافر عميل يريق دماء المسلمين كما يفعل بشار بالكيماوي وبالبراميل المتفجرة وعبر عصابات القتل المأجورة من حزب إيران اللبناني.
أما الصنف الثالث من التغيير بالقوة العسكرية -عبر تدخل الأجنبي- فلا يكون إلا انتحارا سياسيا، وهو مخالف للأحكام الشرعية، إذ يؤدي إلى تسلط المستعمرين مما نهى الله عنه في قوله: "وَلَن يَجعَلَ اللهُ للكافرينَ عَلَى المُؤمنينَ سبيلاً"
إن خلاصة القول أنه لا يمكن للأمة الإسلامية أن تتحرر من هيمنة أمريكا ومن طمع روسيا ومن تطلعات أوروبا إلا بحمل مشروعها الحضاري المناقض للرأسمالية (كفكرة تغيير جذري)، مع الاستناد إلى قوتها الذاتية المتمثلة في عساكر المسلمين (كقوة تنصر الفكرة)، ولا يخالف هذا النهج إلا من يقفز على حقائق التاريخ وعلى الأحكام الشرعية.
12-9-2013