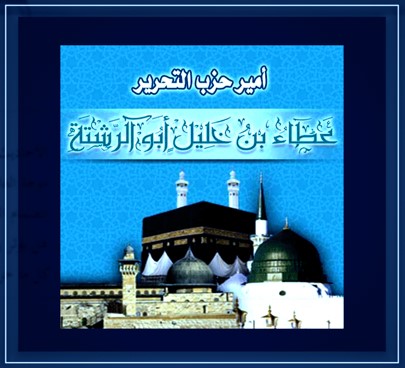الدكتور ماهر الجعبري
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير - فلسطين
منذ أن أُدخلت قضية فلسطين "نفق السلطة"، وصارت فلسطين ذات معنيين: معنى تاريخي ومعني تطبيعي، وتم جر الفصائل إلى "نفق الانتخابات"، الذي حوّل المقاومين إلى أجهزة أمنية، والقضية تُجر من نفق إلى نفق. وكان نفق الصراع والاقتتال هو الأكثر عتمة وظلمة، حتى صارت بقية الأنفاق بالنسبة له مخرجا، من باب قاعدة "أخف الضررين"، أو "أحسن النفقين" !
لقد صارت كلمات "الأنفاق" مع مضادّاتها السياسية "كالحصار" هي مفاتيح التغطية الإعلامية والحراك السياسي والأمني للقضية الفلسطينية.
وصار الحراك السياسي الفلسطيني والعربي، يرتكز دائما إلى "الحوار" في العواصم العربية: في مكة وفي اليمن وفي قطر، وفي دمشق وفي القاهرة. بل صار الحراك الدولي نحو القضية يشترط الحوار والتوافق الفلسطيني، كما استوصت روسيا مثلا خيرا بالحوار الفلسطيني، خلال حراكها نحو مؤتمر موسكو القادم، وطالبت تركيا بإشراك "الإسلاميين" في نفق المفاوضات.
لا شك أن مأزق المقاومة "الوطنية والإسلامية" كبير: فهي منذ دخلت نفق الانتخابات، على مرحلتين، ومنذ تفقّهت أدبيات الأنظمة العربية، على عهدين، ومنذ حشرت خياراتها في الشرعية الدولية، ومنذ أن أجلست قادتها على مقاعد القمم العربية، لم يعد أمامها من خيار يتوافق مع هذه المعطيات إلا خيار "السلطة" والأجهزة الأمنية" "والمعونات"، في مقابل خيار الصراع الداخلي والحصار. وصارت المقاومة عبئا ثقيلا، وهي –مع ترسّخ هذه الحالة- لا يمكن أن تكون أكثر من ورقة ضغط على طاولة المفاوضات.
وازداد هذا المأزق صعوبة لدى المقاومة بعدما أُريقت الدماء في الصراع (أو في الحسم العسكري، سمّه ما شئت)، فإن العودة لمربع المقاومة المسلحة والتخلي عن مربع السلطة وأجهزتها الأمنية، صار يعني واقعيا، تسليم الرقاب إلى أجهزة السلطة الأخرى التي لن تتوقع المقاومة منها حينها إلا أن تُعيد كَرّة الكبت وحلق الذقون "والشبح" على الأعواد، وخصوصا بعدما أضيف دافع الانتقام لدافع الأمن في خارطة الطريق. فصار ترسّخ الأجهزة الأمنية في اتجاهين، وانشطار السلطة إلى سلطتين أمرا واقعا، منعا للدخول في أنفاق السجون من جديد.
إذاً، هذا نفق صعب جدا، وليس من السهل وجود مخرج منه في ظل معادلات أوسلو. وطالما أن تلك المعادلات هي المطبقة، فلا يمكن حلّ الوضع الدموي والصراع، وما تمخض عنه من انشطار أمني وسلطوي. ومن الصعب بل ربما العسير الخروج من ذلك النفق الدموي دون الدخول بنفق سياسي آخر، لا يمكن عبوره مع حمل المقاومة، لأنه يضيق عليها، وبها. وستستمر هذه الصعوبة طالما أن قرار الانقلاب على ثقافة سايكس بيكو غير وراد لدى قادة المقاومة.
إن مأزق قضية فلسطين بقادة العمل الفلسطيني الرسمي أكبر: فهم يجرّون قضية فلسطين في كل يوم من نفق إلى نفق، والكل يدّعي وصلًا بليلى، بينما ليلى تغتصب في تلك الأنفاق، ويريدونها أن تأكل وتشرب من خلال تقديم التنازلات والرضوخ، وأن تخالف المثل العربي القائل "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها". وصار لسان حال القائد فيها أن ينشد لها معزوفة: "إني خيّرتك فاختاري ... ما بين صراع وحصار ... ما بين الذل على عهدي ... أو ضمن ملفات حواري".
فهل يمكن أن نستفيق على اغتصاب المقاومة في أنفاق الحوار ؟ وهل يمكن أن نسمع صراخ قضية فلسطين وهي تجرّ نحو مصير الذلّ والعار ؟
إن رعاية الأنظمة العربية، وخصوصا أجهزتها الاستخبارتية، لعملية اغتصاب قضية فلسطين، وجرها نحو أنفاق لا مخرج منها إلا ضمن مسار التفاوض مع المحتل، لن يحوّل العملية إلى عقد شرعي. ومن يساهم في حصار "الحرة" لن يأبه بما ينالها، بل هو شريك في جريمة ما ينالها من عار وذل، وإن الذي يمنع الغذاء وسلاح المقاومة عن غزة لا يريد غزة إلا منبطحة.
ومع فتح الملفات في القاهرة، وتشكيل اللجان وتحديد الخطوات والبرامج، لا بد أن نتساءل:
هل يمكن أن تُوجد لغة أخرى وثقافة أخرى لذلك "الحوار" الذي انطلق في مصر ؟ وهل يمكن أن ينطلق الحوار في مجال آخر وتحت رعاية أخرى غير الرعاية المخابراتية ؟ وهل يمكن أن تنبثق عنه أدوات أخرى غير "المنظمة" و"الحكومة" و"الأجهزة الأمنية" "والانتخابات" ؟
هل يمكن أن يؤدي الحوار إلى استعادة رشد العمل السياسي لتحرير فلسطين والتمرّد على لغة الواقعية السياسية التي حصرت القضية في تلك الأنفاق، ويؤدي إلى استعادة الخطاب السياسي الذي يوصل لاستعادة فلسطين كاملة ؟
هل يمكن أن نتذكّر أن الاحتلال ليس فقط الذي بدأ عام 67 ؟ وأن فلسطين وحدة واحدة وأن تحريرها هو عملية تخلّت عنها الأنظمة وأن مهمة التحرير لا تتم إلا من خلال جيش واحد يتحرر من هيمنة تلك الأنظمة ؟
لا شك أن هذه أسئلة "خارجة" عن سياق الحدث الرسمي، وخارجة على ثقافة الحوار الوطني، وخارجة على الشرعية الدولية، وخارجة على النظام العربي، وخارجة عن طاولة الحوار الفلسطيني، ولذلك فليس واردا أن يتعاطاه إعلام الأنظمة، ولا أن ترعاها أجهزة الأنظمة.
والخروج على السلطان هو دائما محفوف بالمخاطر، ويعرّض صاحبه للجوع إن لم يكن للقتل، فكيف إذا كان الأمر خروجا على شرطي العالم الأمريكي وتمردا على إرادة أعوانه ؟ فهو قد خط خارطة الطريق، التي حيثما قلّبتها تجد شرعنة الاحتلال وحفظ أمنه، ومن ثم وقع عليها حلفاؤه في أوروبا، ورتّلت الأنظمة العربية ترانيمها في كل قمة عربية مؤكدة في كل مرة أن خيار الأنظمة الوحيد هو خيار التفريط بما احتل من فلسطين "التاريخية" لاستعادة فلسطين التي تعرّفها الشرعة الدولية: ِشبه دولة تحقق للاحتلال أمنه. وكل حوار تحت أمر السلطان لن يتمكن من الخروج عن هذه السياقات؟
إن أخوّة أهل فلسطين وحقن دمائهم وعناق المقاومين منهم فريضة وحاجة. وكل جهد يصب في اتجاه ترسيخ السلم الأهلي ممدوح طالما أنه لا يكون على حساب تقديم التنازلات أو التمهيد للتنازلات. إلا أن الحوار نحو ذلك الهدف، يجب أن لا يعني الالتقاء في منتصف الطريق: بين حرمة التنازل عن الأرض وبين مباركة التنازل، ويجب أن لا يكون الهروب من ذلك النفق من أجل الدخول في أنفاق جديدة من "السلطة" والأجهزة الأمنية" "والانتخابات" "والمنظمة".
إن ملفات الحوار يجب أن تكون حول التعاهد على استرجاع المرجعية الأصيلة لقضية فلسطين، وهي مرجعية الأمة الإسلامية، وحول التواثق على رفض مشاريع التفاوض مع المحتل، وحول التوافق على جهد سياسي لمطالبة جيوش الأمة للقيام بواجبها: فهل يمكن أن تكون هذه الملفات على طاولة الحوار ؟ أم أنها تؤدي إلى قلب الطاولة ؟
هذه تساؤلات تعبر عن نبض الناس الغائبة عن الحوار، أطرحها على الساسة والقادة علّها تنقذ من يسألها من إثم السكوت على جر قضية فلسطين نحو أنفاق لا تخرج منها إلا وهي تحمل ملفات التفاوض والتنازل والتفريط.
منذ أن أُدخلت قضية فلسطين "نفق السلطة"، وصارت فلسطين ذات معنيين: معنى تاريخي ومعني تطبيعي، وتم جر الفصائل إلى "نفق الانتخابات"، الذي حوّل المقاومين إلى أجهزة أمنية، والقضية تُجر من نفق إلى نفق. وكان نفق الصراع والاقتتال هو الأكثر عتمة وظلمة، حتى صارت بقية الأنفاق بالنسبة له مخرجا، من باب قاعدة "أخف الضررين"، أو "أحسن النفقين" !