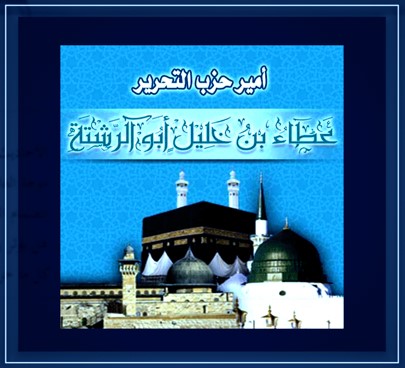مشروع السلطتين الفلسطينيتين:
2- الالتحام الدموي والانشطار السلطوي
الدكتور ماهر الجعبري
مع انتهاء الحالية الانبطاحية للمنظمة ورجالاتها أمام متطلبات الأمن "الإسرائيلية"، ومع تنظيف وسطها السياسي مما ليس أمريكيا، أتاحت خارطة الطريق (الأمريكية) الفرصة أمام أوروبا لمحاولة الدفع برجالات جدد على مسرح السلطة عبر الانتخابات التشريعية في العام 2006، وكانت حركة حماس قد بدأت مد الجسور نحو المجتمع الدولي، ومن ثم تورطت في وحل السلطة تحت الاحتلال، وشكلت الحكومة الفلسطينية، متغافلة عن مواقفها السابقة، وعن الرفض المبدئي الذي كان قد خطه الرنتسي رحمه الله، ونفخت بذلك الروح في مشروع السلطة، ومكنت أمريكا من متابعة السعي في توريط الشعار الإسلامي في مشروعها الوسخ عبر لعبة الديمقراطية.
إلا أن "العرس الديمقراطي الفلسطيني" لم يدُم طويلا، إذ بدأ الشقاق يدب بين الفرقاء سريعا، وظهرت بدايات الاقتتال الداخلي خلال أسابيع من تسلم قيادات حماس للسلطة، وعلى إثر ذلك صدرت وثيقة الأسرى (من مختلف الفصائل في السجون الإسرائيلي) في حزيران 2006، لترجح خيار المشاركة في الانبطاح على خيار المواجهة بالسلاح، ولتفتح الطريق المشترك بين حماس وفتح نحو الاعتراف بالاحتلال اليهودي من خلال صيغ لغوية مركبّة وملتوية (وثيقة الأسرى)، وكانت وثيقة الأسرى إبداعا لغويا في التركيب والالتفاف على "الثوابت"، بدل أن تكون نصيحة مخلصة للعودة لثوابت الأمة، والإصرار على رفض أي شكل أو عمل يمهد للتنازل.
ودارت كلمات تلك الوثيقة المفتاحية حول مصطلحات الحلول السلمية (التي كانت قد تأصلت عند المنظمة)، وركزت الوثيقة على "توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية"، وهكذا تجرّأت وثيقة الأسرى على استخدام تعبيرات سياسية كانت تعتبر من أدبيات المفرّطين. ثم تحدثت عن تخصيص منظمة التحرير ورئيس السلطة (الذي هو مهندس أوسلو) بالمسئولين عن إدارة المفاوضات، بدل أن تجزم بحرمة التفاوض مع الاحتلال، وبدل أن تحمّل عباس وزمرته المسئولية التاريخية عن مسيرة التفريط. وبالطبع غُلّفت كل تلك الانحرافات عن ثوابت التحرير بالحديث عن عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني أو لاستفتاء عام.
وهكذا أوجدت وثيقة الأسرى أفقا جديدا للتحرك الحمساوي-الفتحاوي المشترك نحو حل الدولتين (الأمريكي)، وتم الترتيب لعقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس السلطة (عباس) ورئيس الحكومة (هنية)، للإعلان عن الموافقة على وثيقة الأسرى، غير أن الطرفين تفاجآ عندما تم اختطاف الجندي "الإسرائيلي" شاليط، فتعطل ذلك المؤتمر الصحفي، وتعطلت من بعده المشاركة في الحلول السلمية. وأصبح شاليط الذي تم أسره من خلال عملية مشتركة من ثلاثة فصائل فلسطينية ملفا من ملفات قضية فلسطين، وتسلمته حركة حماس، لتبدأ به مشوارا طويلا من المفاوضات مع "إسرائيل" عبر الوسطاء.
وظلّ موقف الاعتراف الصريح صعبا على قادة حماس، ولم تستخدم عبارات واضحة تفيد مباشرة بالاعتراف، إذ كان ذلك يشكّل خطرا حقيقيا على بنيان الحركة، وخصوصا أنها ضمّت مخلصين تحركوا بدافع حب الجهاد والاستشهاد، وعلى رأسهم المقاومين في جناحها العسكري. ولذلك برزت الحاجة لعملية ترويض طويلة، كما حصل مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع حركة فتح، التي كانت أيضا قد ضمّت عند انطلاقها المخلصين المندفعين للقتال من أجل التحرير، واحتاجت فتح ردحا من الزمن حتى تفصح عما كانت تخفيه من اتصالات سرية مع اليهود ومن توجهاتها المبكرة نحو الاعتراف بالاحتلال للأرض المحتلة عام 1948.
وظهرت إشارات سير حماس على خطا فتح في الترويض، وبدأت قيادات حماس في مرحلة من تمييع الألفاظ، والتراقص في التصريحات بين المعاني اللغوية للكلمات وبين المفاهيم السياسية: فصارت تتحدث عن الهدنة طويلة الأجل بدل السلام الدائم، وعن إعادة تأهيل المنظمة بدل الانخراط المباشر في وحلها التآمري، وعن أشكال متعددة للمقاومة بدل الجهاد بالسلاح، وعن استراحة المحارب بدل وقف العمل العسكري، وعن دولة في حدود 1967 كحل مرحلي (تماما كما كانت فتح –والمنظمة- قد بدأت تمرير ذلك التنازل تحت شعار "خذ وطالب").
وفي تلك الأثناء، حصلت حرب تموز 2006، عندما شنّت "إسرائيل" هجوما عسكريا على لبنان في محاولة منها لنزع سلاح حزب الله حسب ترتيبها مع أمريكا، التي كانت تسعى لتمهيد الأجواء لتحريك مسار الحل السياسي مع سوريا، حتى تتلازم المسارات التفاوضية. وانطلقت شرارة تلك الحرب بعد قيام مقاتلين من حزب الله بخطف جنديين يهوديين. ولكن وجود مسلمين مخلصين كانوا متعطشين لردّ الصاع صاعين لجيش اليهود، مكّن من رد الهجوم ودحر المعتدين على أعقابهم خاسرين خائبين، وهو ما أزّم الموقف "الإسرائيلي"، وهزّ موقف أولمرت في رئاسة الحكومة، ودفع الكيان "الإسرائيلي" لتشكيل لجان تحقيق للبحث في أسباب الهزيمة.
وتزامنت تلك التطورات العسكرية والسياسية على المحور الشمالي، مع وضع حكومة حماس تحت الحصار الاقتصادي، في محاولة للتجويع من أجل التركيع، وتصاعدت أزمة رواتب الموظفين في السلطة، وكانت منظمة التحرير قد خلقت "جيشا" من الموظفين ضمن كوادر البطالة المقننة. وحاولت حماس أن تدير الموقف كأنها تدير مؤسسة خيرية، وصار رئيس الحكومة يتحدث عن التزوّد بالزيت والزعتر، وحاولت قياداتها جمع التبرعات من جيوب الناس عبر حملات كأنها جمعية خيرية، إلا أن الأزمة استمرت في الضغط على بطون الناس، من أجل دفع عقولهم نحو قبول الاعتراف الواضح بكيان "إسرائيل".
وتكرر الاقتتال الداخلي بين رجالات فتح وحماس، ثم احتدم مرة أخرى في كانون ثان 2007. ووجه حــزب التحريـر في 28/1/2007 نداء "إلى أهل فلسطين بعامة، وفتح وحماس بخاصة" دعا فيه لحقن الدماء، وكشف فيه توريط الساسة لأتباعهم في اقتتال حول تفاصيل برنامج سياسي لدويلة هزيلة.
وصار أهل فلسطين يعيشون بين خيارين: إما الاقتتال بين فتح وحماس أو حكومة وحدة وطنية تقوم على شكل من الاعتراف بكيان "إسرائيل". وهكذا تضافر عاملان لتمرير فكرة حكومة الوحدة الوطنية (التي تقوم على برنامج الاعتراف) وهما التجويع وإسالة الدماء، ونجحت الخطة نسبيا، وبرزت حكومة الوحدة الوطنية كمطلب جماهيري.
وفي محطة من محطات الصراع، تم توقيع اتفاق مكة في شباط 2007 بمباركة أمريكية وتحت رعاية ملك السعودية، الذي هو عرّاب المبادرة العربية للسلام، وتغافلت حماس عن مواقف الملك عبد الله التطبيعية تلك، بل وقف رئيس مكتبها السياسي -خالد مشعل- يشبّهه بالرسول صلى الله عليه وسلّم إذ يفرد عباءته للصلح –ولرفع مشروع السلطة- كما فرد الرسول عباءته لقبائل قريش (لرفع الحجر الأسود)!
وتم إخراج التوافق السياسي على مشروع السلطة والتفويض بالمفاوضات على أنه حقن للدماء. وأخذت حركة حماس تتحدث عن "الالتزام" بقرارات القمم العربية (وهي كانت بالطبع قد اعترفت بإسرائيل وبحل الدولتين)، وتتحدث عن "الاحترام" لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. وثار جدل لغوي موسع حول التفريق بين معاني الالتزام والاحترام، ضمن حالة من توظيف الألفاظ للالتفاف على الثوابت الراسخة في وعي الناس حول حرمة الاعتراف بالاحتلال وحول حرمة الاتفاقات والقرارات التي تصب في ذلك. وصار الخطاب السياسي المشترك يستغبي الناس، التي تدرك بداهة أن قرارات القمم العربية كانت تواترت تؤكد الاعتراف بالاحتلال وآخرها المبادرة العربية للسلام.
وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة برئاسة إسماعيل هنية، وقد تم ترتيبه بمباركة أمريكية، بعد تخطيط أمريكي مسبق كما تضمن تقرير بيكر-هاملتون (الأمريكي)، الذي صدر نهاية العام 2006، الذي ربط علاج المأزق في العراق بقضية فلسطين، وأوصى بدعم حكومة الوحدة الوطنية مؤكدا على حل الدولتين، "وتقديم دعم قوي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لأخذ زمام المبادرة في تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات مع إسرائيل، وبذل جهد كبير في دعم وقف إطلاق النار" (ملخص نص تقرير بيكر-هاملتون).
وكانت تلك الخطوة تمهيدا لإعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام رسميا مع توريط حماس فيها، ولذلك شاركت قيادات حركة حماس في القمة العربية التي عقدت في الرياض بتاريخ 28/3/2007 مع عباس، ووافقت حماس على أن تكون حاضرة وسط حكام يتحدثون عن مبادرتهم التطبيعية، وعن برنامجهم للتفريط، متغافلة عن تاريخهم الخياني وعن حالهم الانبطاحي. وبدأت حماس بذلك مرحلة من العلاقات الرسمية مع الأنظمة التي فرّطت بقضية فلسطين.
وهكذا التقت الرموز "الإسلامية" والعلمانية على طاولة المؤامرات العربية. وتحركت المبادرة العربية للسلام قدما على الساحة الدولية، أما قادة "إسرائيل" فقد ظلّوا يناورون للخروج من المأزق ومن الضغوط الأميركية عليهم للسير في عملية السلام.
ورغم التوافق السياسي على مائدة الأنظمة العربية، ظلت أوساط الحركتين مسكونة بأحقاد التعذيب الذي تعرضت له رجالات حماس في سجون سلطة فتح. ولم تدم تلك الأجواء التصالحية، وانقشعت غيوم المصالحة عن صيف ساخن عام 2007، واندلعت أحداث غزة الدموية بين فتح وحماس، فلطخت صورة الفلسطيني المناضل أمام شعوب الأمة الإسلامية، وقامت القوى العسكرية في حماس بتصفية الوجود الفتحاوي في غزة، وسيطرت على المقار الأمنية، مما أدى إلى انشطار سلطوي فعلي، وصفته حماس بالحسم العسكري، ووصفته فتح بالانقلاب، وصار يسمّى حالة "الانقسام".
ودخلت القضية في مرحلة الصراع الفصائلي المفضوح. وصار هنالك ردح إعلامي بين شقي السلطة، وقمع أمني لرجالات الطرفين، لا زالت أصداؤه مستمرة حتى الساعة.
وترسخت أقدام حكومة حماس في غزة، وأخذت تمد جسورها السياسية نحو إيران، وتوطدت علاقات قيادات حماس مع النظام السوري، فيما تشكلت حكومة برئاسة سلام فياض (الذي كان وزير المالية تحت رئاسة هنية!) في رام الله منذ تموز 2007، وبدأ اسمه يلمع على الساحة الفلسطينية، وبدأت مرحلة "الفياضية" في الضفة الغربية، مما تستدعي وقفة في حلقة قادمة من هذه السلسلة.
وتزامن ذلك الانشطار السلطوي مع بروز لاعب أمني جديد على ساحة سلطة رام الله، وهو الجنرال الأمريكي ديتون الذي وصفه البعض تهكّما بأنه "زعيم فلسطين". وردّت حكومة فتح على الأعمال الدموية في غزة باستشراس أمني في الضفة الغربية، وصل إلى ارتكاب جرائم قتل في الضفة الغربية وفي سجون السلطة. وتمخض عن ذلك الاحتدام عن قمع أمني بالضفة الغربية صار مبررا بالدوافع الأمنية والصراع على السلطة.
وهكذا تمثل المشهد على الساحة الفلسطينية في تلك الفترة بتعطل خطة أمريكا وخارطة الطريق بعد احتدام الصراع الدموي على السلطة، وبعد فشل المحاولة السعودية الأولى لتمرير مشروع تصفية قضية فلسطين. وصارت السلطة سلطتين، وصار الهم ماليا وتنافسا على الحضور، وعلى تحقيق الاعتراف بالشرعية.