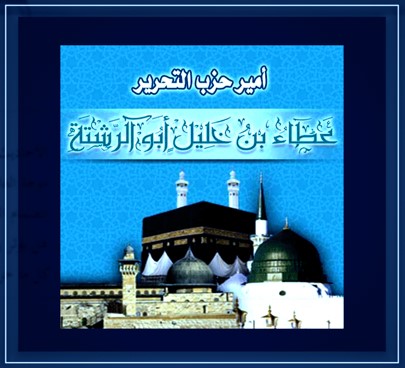قضية فلسطين 2: نشأة الحلول السياسية حسب رؤى استعمارية
ضمن سلسلة "قضية فلسطين"، يتناول هذا المقال (المطول الثاني) المراحل الأولى لتطور قضية فلسطين كقضية سياسية ضمن الصراع الرأسمالي على المصالح، ويكشف أن تحركات الأنظمة العربية ظلت دائما ضمن تلك السياقات من الصراع الدولي، وأن فصائل العمل الوطني "تتغافل" عن تلك الخلفية في تبنيها "لحل إقامة الكيان الفلسطيني"!
يتضح من خاتمة العرض التاريخي السابق، أن قضية فلسطين انبثقت عندما قررت بريطانيا سحق الخلافة في الحرب العالمية الأولى خلال صراعها العسكري والسياسي مع دولة الخلافة العثمانية. وبعدما فشل اليهود في إغراء السلطان عبد الحميد لإقناعه بتأسيس وطن قومي لهم، التقت تطلّعاتهم مع مصالح بريطانيا، وبدأت بوادر ذلك التوافق منذ صياغة مذكرة الوزير البريطاني (اليهودي) صاموئيل سنة 1908 لتحقيق وطن قومي لليهود يحقق مصالحت بريطانيا.
وكانت الرؤية الأساسية للقوى الاستعمارية الفاعلة في ذلك الوقت، تتمثل في إيجاد كيان دولي في فلسطين، وذلك ضمن مشروع تمزيق الخلافة، كما نصت معاهدة "سايكس بيكو" الموقعة عام 1916 بين بريطانيا وفرنسا باطلاع روسيا، ولما أفشت روسيا سر تلك المعاهدة بعد ثورتها عام 1917، تم إصدار "وعد بلفور" عام 1917 من قِبَل بريطانيا لطمأنة اليهود، وأقّرته فرنسا وإيطاليا عام 1918، ثم أمريكا عام 1919.
ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، احتلت بريطانيا فلسطين حتى تسهّل لليهود هجرتهم إلى فلسطين، وذلك كي تتخلص أوروبا منهم ومن مشاكلهم وحقاراتهم وإفسادهم، ولتجعلهم بريطانيا أداة متقدمة في يدها، ولتشغل المنطقة بصراع مرير مع اليهود لصرفهم عن استعادة الخلافة.
وتم تعريف فلسطين على وضعها الحالي ضمن ما يسمى "حدود فلسطين التاريخية"، نتيجة سلسلة من المفاوضات والاتفاقيات بين القوى الاستعمارية مطلع القرن العشرين. وفيما استمر تدفّق الهجرات اليهودية إليها وتشكّل عصاباتهم، صدر عن بريطانيا الكتاب الأبيض لسنة 1939، الذي حدد رؤية بريطانيا بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة تكون محكومة من قبل العرب الفلسطينيين واليهود بشكل طائفي حسب نسبة كل منهما. وهو ما يعتبر توثيقا رسميا مبكرا لما يُعرف بحل الدولة الواحدة الذي ظلت أصداؤه طيلة العقود التي تلت، كرؤية بريطانية لحل القضية الفلسطينية.
ومع أن أمريكا كانت تعيش في عزلة دولية حتى الحرب العالمية الثانية، إلا أن بداية تدخّلها بالقضية الفلسطينية ترجع إلى عام 1919 لدى موافقتها على وعد بلفور بعد صدوره بعامين. ولما خرجت أمريكا من عزلتها بعد الحرب العالمية الثانية بدأت أطماعها بالظهور كدولة استعمارية، وتقدمت نحو بلاد المسلمين لكي تبسط هيمنتها وترث خيراتها عن بريطانيا، ولذلك نشأ صراع قوي على المصالح وعلى النفوذ السياسي بين الدولتين، وكانت فلسطين ساحة من ساحته.
وكانت الجامعة العربية حلبة التآمر على القضية الفلسطينية منذ نشأتها في العام 1945، وقد كانت تلك النشأة حلقة في صراع الغرب ضد الأمة الإسلامية، حيث كانت بريطانيا وراء ذلك التأسيس، ودفعت الملك فاروق وحزب الوفد في مصر لحضانتها، لتكون مظلة وحدة صورية تسد تطلعات الأمة للوحدة الحقيقية، إضافة لترسيخها الحدود بين الكيانات التي نشأت عن معاهدة سايكس بيكو، وما تلاها في سان ريمو، وظلّت غطاء للمؤامرات الدولية على فلسطين طيلة عقود.
وبينما دارت معظم الأحداث ذات الصلة بالقضية الفلسطينية في النصف الأول من القرن الماضي حول محور بريطانيا، بدأ تأثير أمريكا بالبروز مع منتصف القرن الماضي، وسارعت لاحتضان الكيان اليهودي في فلسطين وصارت تعمل على تولّيه دوليا واقتصاديا, ثم أصبحت أحرص دولة في العالم على احتضان دولة اليهود وحمايتها, وصار مشروع الكيان اليهودي جزءا من سياستها الخارجية: لتكون "إسرائيل" قاعدة لها في الشرق الأوسط ضد المسلمين، بالتوازي مع تأسيس قاعدة دولية في القدس، تكون سندا لذلك الكيان، وجاهزة للتدخل والتصدي في حالة عدم قدرة دولة اليهود على الصمود أمام المسلمين، فتمنع بذلك المسلمين من استرجاع القدس, ومن القضاء على دولة اليهود.
وفي 18/3/1948، أي قبل إعلان الدولة اليهودية في حرب "النكبة" بشهرين تقريبا، استقبل الرئيس الأمريكي ترومان الزعيم اليهودي حايم وايزمان سراً وتعهد له بالاعتراف بالدولة اليهودية في 15 أيار من العام نفسه (تسلسل التاريخ الفلسطيني منذ العصور الأولى حتى عام 1949). ولما أحالت بريطانيا ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة عام 1947 حتى لا تأخذ على عاتقها وحدها إنشاء الدولة، رفضت لجنة فلسطين الدولة المتحدة في 25/11/1948، وأيدت مشروع التقسيم (النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود)، وصدر قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية في 29/11/1948 (رقم 181)، حيث تضمن نصه أنه: "تؤسس في فلسطين دولتان مستقلتان: واحدة عربية وأخرى يهودية. تؤسس في القدس إدارة دولية خاصة..."، وأعطى مشروع التقسيم ما نسبته 56.5% من فلسطين لليهود، وتضمن تشكيل الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني للدولتين العربية واليهودية (نص قرار التقسيم رقم 181). وكانت أمريكا ممن دفع نحو صدور ذلك القرار. ووافقت ثلاثة من الدول العظمى في ذلك الوقت (روسيا وأمريكا وفرنسا) على القرار، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، ومارس عدد من السياسيين ورجال الأعمال الأمريكيين الضغوط على الدول المترددة التي كانت مرتبطة بالولايات المتحدة اقتصاديا، ويُنقل عن وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جيمس فورستل في مذكراته تعليقا على هذا الموضوع قوله: "إن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة"، مما يمكن اعتباره بداية انطلاق التدخل الأمريكي في القضية الفلسطينية. وشكّل القرار نواة حل الدولتين، مع مشروع تدويل القدس، وصارا معلمين من معالم الحل الأمريكي للقضية الفلسطينية.
ومن المعلوم أن بريطانيا كانت قد أسست علاقات قوية مع قادة اليهود، وكان لها نفوذ بين ساسة يهود الأوائل، ومنهم الذين أسسوا وقادوا حزب العمل الذي حكم دولة اليهود لمدة 30 عاماً منذ تأسيسها، من أمثال "بن غوريون" وكانوا من معارضي التقسيم: وكان بن غوريون قد أعلن منذ عام 1938 أمام قيادة الوكالة اليهودية معارضته لفكرة التقسيم، وظل معارضا لها، ولدى صدور القرار رقم 181 صرّح بيغن ببطلان شرعية التقسيم.
وعشية حرب عام 1948، أعلنت قادة العصابات اليهودية إقامة دولتهم، دون تحديد حدود الدولة في الإعلان، واكتفت بتعريفها "دولة يهودية في إيرتس يسرائيل" أي "أرض إسرائيل"، وسارع الرئيس الأمريكي هنري ترومان للاعتراف بدولة اليهود بعد دقائق من إعلانها يوم 14-5-1948، ولدى تقدّم دولة اليهود للعضوية في الأمم المتحدة، حصل جدل سياسي في أروقتها يعكس تباين الرؤى الدولية:
تقدمت الحكومة المؤقتة "لإسرائيل" في نهاية عام 1948 بطلب انضمامها للأمم المتحدة، وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الطلب احتدم الجدل "القانوني" بين المندوب السوري من جهة ومندوب الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى حول مدى انطباق شروط العضوية على "إسرائيل"، حيث انبرى المندوب الأميركي للدفاع عن "جدارة إسرائيل" بالعضوية، ومن المعروف أن أمريكا وروسيا كانتا متحمستين في جلسة 2/12/1948 للتوصية بالقبول، فيما كان رأي بقية الدول الأعضاء في المجلس أن ذلك القبول سابق لأوانه، ولما أحال المجلس الطلب إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد فيه"، لم تبت بقرار، وقرر مجلس الأمن تحويله للتصويت، ففشل مشروع القرار الذي أيدته أمريكا وروسيا، فيما امتنعت عن التصويت عليه (فرنسا وبريطانيا والصين). فأعادت "الدولة اليهودية" التقدم بطلب ثان في شباط 1949، وعند إجراء الاقتراع في مجلس الأمن في 4/3/1949، امتنعت بريطانيا عن التصويت مرة أخرى، وأصدر مجلس الأمن توصية بالقبول، وعارضت مصر ذلك القبول (وكانت رجالاتها بريطانية الولاء). ولما أحيلت توصية مجلس الأمن هذه إلى الجمعية العامة للنظر فيها، تجدد الجدل القانوني والسياسي، وفي النهاية صدر قرار الجمعية العامة رقم 273 (3) بتاريخ 11/5/1949، الذي قرر شرعية دولة "إسرائيل" (دور الولايات المتحدة الأميركية في قبول (إسرائيل) عضواً بالأمم المتحدة).
ومع منتصف القرن الماضي، قررت أمريكا أن تلقي بثقلها على الساحة الدولية، وأن تتفرد بمعالجة القضايا الساخنة، ويعتبر الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جورج ماغي بالسفراء والممثلين الأمريكيين في المنطقة، في مؤتمر استانبول عام 1950، نقطة فاصلة في تحرك أمريكا نحو الدخول بثقل في ملف القضية الفلسطينية، وقد تبلورت عن الاجتماع توصية (إستراتيجية) تم رفعها للبيت الأبيض تقضي بضرورة فصل السياسة الأمريكية عن السياسة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط. وتمخض عن ذلك الاجتماع تشجيع هيئة الأمم المتحدة على تنفيذ مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية، مما يمثّل الرؤية الأمريكية الثابتة لحل القضية الفلسطينية.
وفيما عملت بريطانيا على متابعة القضية كصراع بين الدول العربية "وإسرائيل"، قامت إستراتيجية أمريكا نحو القضية الفلسطينية على حصرها بين "عرب فلسطين" واليهود، وعلى تقرير حالة عدم التكافؤ بين الطرفين, مما يُسهل الوصول لتحقيق الهدف الأمريكي. ومن ثم مارست أمريكا سياسة العصا والجزرة ودفعت الدول العربية التابعة لها في ذلك الوقت (مصر والسعودية والعراق) لأن ترفع أيديها عن القضية الفلسطينية، وأن تحصر مسئولية "تحريرها" في أهل فلسطين، فيما يقتصر دور الدول العربية على "الدعم والتمويل"، وهو ما يؤدي لحالة يأس لدى أهل فلسطين، ومن ثم يجعلهم يستسلمون للحل الأمريكي.
وبعد العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا بمشاركة دولة يهود على مصر عام 1956، أعلنت أمريكا "مبدأ إيزنهاور" الذي حدد أسس تحركاتها وتدخلاتها العالمية، حيث أصدرته تحت دعوى وقف التوسع السوفياتي في المنطقة، فيما كانت غايته ملء الفراغ الذي تركه زوال نفوذ بريطانيا وفرنسا من الشرق الأوسط بعد هجومها على مصر، وكشف خطاب الرئيس الأمريكي ايزنهاور، في بيانه أمام الكونغرس بتاريخ 5/1/1957، عن تطلعات أمريكا لان تحل محل بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، لتأمين المصالح الأمريكية التي انتشرت في نواحي المنطقة، ولتوسيع التحركات الحيوية الأمريكية فيها، ويتضمن ذلك بالطبع إرساء دعائم "إسرائيل" كدولة غربية قوية. وكان الخطاب قد ركّز على عدم الاستقرار والقلاقل التي اجتاحت المنطقة بسبب وجود "إسرائيل". وبالطبع تشجعت أمريكا على تفعيل سياستها تلك في ظل خنوع الأنظمة العربية وسذاجتها، فكان "مبدأ إيزنهاور" إعلانا لسياسة استعمارية عدوانية.
وبدأت خطوات أمريكا العملية لمحاولة تنفيذ الحل تتزايد، وبدأت تفصيلات رؤيتها بالتبلور أواخر حكم أيزنهاور خلال عامي 1959-1960، على أساس حل الدولتين، حيث تبنّى الرئيس الأمريكي آيزنهاور توصيات مؤتمر استانبول (تطبيق سياسة منفصلة عن السياسة البريطانية)، وأخذ يحثّ الزعماء العرب على إقامة كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مع تدويل القدس. وكانت الغاية من ذلك أن تستولي أمريكا على القدس تحت شعار تدويلها، ولتكون قاعدة بيدها لضرب المسلمين، مع إجبار بقية الدول على حمايتها كونها دولية، وتحقق إقامة كيان فلسطيني يفصل بين دولة اليهود والأردن, لرفع يد اليهود عن الأردن وفصلهم عنها، حيث تأصّل الأردن كقاعدة سياسية لبريطانيا في المنطقة، وتضمنت رؤية أمريكا لحل مشكلة اللاجئين إعادة قسم ضئيل منهم, وتعويض الأكثرية الساحقة، وتوطينهم خارج المنطقة المغتصبة (منطقة 1948 في ذلك الوقت) أو في البلاد العربية. ثم ترجم الرئيس الأمريكي كيندي تلك الرؤية الأمريكية أو أكّدها ضمن خطابات رسمية أرسلها للحكام العرب (في مصر والسعودية والعراق والأردن ولبنان) عام 1961، متعهدا فيها بتمويل قضية اللاجئين وبحل مشكلة المياه.
وهكذا تبلورت سياسيا أطروحتان دوليّتان حول القضية الفلسطينية تمثلتا بحل الدولة الواحدة كرؤية بريطانيا، وحل الدولتين (مع تدويل القدس) كرؤية أمريكية، وظل هنالك صراع سياسي حول الرؤيتين، انعكس في تحركات الأنظمة العربية وحكامها الذين توزّعوا في ولاءاتهم بين القوتين الاستعماريتين، واختلفوا في أعمالهم وبرامجهم السياسية بناء على ذلك. ومع ذلك ظلّت الدولتان العظميان تتنافسان على تثبيت دولة اليهود ورعايتها رغم تباين مصالحهما بشأنها وتباين طرقهما في تسخيرها وتشكيلها.
وهنالك محاولات معاصرة لدى بعض الكتّاب والإعلاميين لإنكار حالة ذلك الصراع على المصالح والنفوذ، وإنكار وجود التآمر الغربي على الأمة الإسلامية تحت شعار رفض "نظرية المؤامرة"، وهو يقوم على منطق سطحي: إذ العالم يتحرك حسب المصالح، وكيف به عندما تكون دوله الفاعلة رأسمالية نفعية تتأصل في بواطنها مشاعر صليبية دفينة؟ ثم إن دراسة تطور الأحداث والتصريحات بموضوعية وبتوثيق يكشف بجلاء تلك المؤامرة وذلك الصراع، وهذا ما تبرزه هذه المراجعة.
وبدأت محاولة إقامة الكيان الفلسطيني على يد أيزنهاور، عندما دفع جمال عبد الناصر في مصر نحو البدء بتنفيذ المشروع، ودفع حاكم العراق آنذاك عبد الكريم قاسم لمساندته سياسيا من خلال الدعوة إلى الجمهورية الفلسطينية، إضافة إلى تحريك الملك سعود نحو تلك الغاية (وكانوا ثلاثتَهم من رجالات أمريكا):
كان جمال عبد الناصر في مصر عرّاب الرؤية الأمريكية، فيما كان الملك حسين في الأردن عرّاب الرؤية البريطانية: وتحرك عبد الناصر لإقامة الكيان الفلسطيني، ودعا لإيجاد الاتحاد القومي للفلسطينيين، وأخذت وسائل الإعلام تدعو له في مصر وسوريا (المتحدتين في ذلك الوقت)، ومن ثم تبنته السعودية علنا وعرضته على الجامعة العربية في اجتماعها الذي عقدته في القاهرة سنة 1959، فيما عارضته الأردن في ذلك الاجتماع بشده، مما عطل مسيرة نجاح المشروع الأمريكي.
وتصاعد الضغط الأمريكي على الأردن، وعقدت الجامعة العربية سلسلة اجتماعات ولقاءات لتلك الغاية في شتورة بلبنان سنة 1960, ولما رضخ هزّاع المجالي رئيس وزراء الأردن للموافقة على الكيان الفلسطيني تحت الضغط الأمريكي، وأرسل تعليمات الموافقة لوفد الأردن في شتورة برسالة مستعجلة من عمان، وافق مؤتمر شتورة على الكيان الفلسطيني في اللحظة الأخيرة بالإجماع، فتم اغتيال المجالي بعد أسبوع من المؤتمر. وظل الملك حسين يبدي المعارضة الشديدة للكيان الفلسطيني وتدويل القدس.
ثم تحركت رجالات أمريكا في المنطقة من جديد على إثر رسائل الرئيس الأمريكي كيندي للحكام العرب عام 1961، فتم عقد مؤتمر الجامعة العربية في القاهرة في 10/6/1961، ومارست أمريكا سياسة العصا والجزرة على الأردن، وكادت أن تؤتي أُكلها، حيث يُنقل الحديث عن صفقة بين السفير الأمريكي في عمان وبين بهجت التلهوني رئيس وزراء الأردن حينئذ، أحبطها الملك حسين خلال ساعات، كما كشفت مذكرة حزب التحرير للملوك والرؤساء في 1962.
ثم تحركت أمريكا عبر ملعب الأمم المتحدة، واستغلت لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين عام 1961 حول قضية اللاجئين، وأرسلت اللجنة المبعوث الأمريكي جونسون سنة 1961 لجولة على الدول العربية، تحت مسمى مبعوث خاص لبحث بعض الوسائل العملية لتحقيق تقدم بشأن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين (الإطار النظري-مشاريع التوطين)، فيما كان يسعى لدفع المشروع الأمريكي، وصار جمال عبد الناصر يدعو علنا لتحكيم لجنة التوفيق وتفعيلها، كأداة للضغط على الأردن للموافقة على الكيان الفلسطيني وعلى تدويل القدس، حسب الرؤية الأمريكية. وحقق جونسون تجاوبا من قبل الحكّام إلا في الأردن، حيث أعلن التلهوني رئيس وزراء الأردن أن الأردن لا يقبل من جونسون التدخل في القضية إلا في نطاق مهمته وهي تتعلق بتصفية اللاجئين، حيث بدا أن جونسون سعى لمشروع تدويل القدس وإيجاد الكيان الفلسطيني، فاخفق جونسون في مهمته الأولى.
ثم عاود جونسون الكَرّة مرة ثانية في العام 1962: ومكث في "إسرائيل" يفاوض ساستها الذين عارضوا التدويل والكيان الفلسطيني، حيث كان الوسط السياسي فيها مرتبطا بالبرامج السياسية البريطانية. واستعانت أمريكا بالملك سعود على إقناع ملك الأردن للموافقة على التدويل وعلى الكيان الفلسطيني، ونشط معه أحمد الشقيري (الفلسطيني) الذي كان يشغل منصب وزير الدولة في السعودية، وقد نقلت الأوساط السياسية، كما كشفت مذكرة حزب التحرير للملوك والرؤساء في 1962، عن الشقيري قوله "غسّلوا أيديكم من فلسطين ومن القدس فإنها ستدول"، وسئل عن عودة اللاجئين فقال: "هذا كلام، ما لهم إلا التعويض".
ولما حصل بعض التجاوب من الأردن، وجرت لقاءات بين كل من الملك حسين، ورئيس وزراءه مع أعضاء "الهيئة العربية العليا لفلسطين" (التي كانت قد تشكلت بموجب قرار من الجامعة العربية عام 1946 كجهة سياسية فلسطينية)، تسرّب حديث عن الاتفاق على تدويل القدس وإنشاء حكومة فلسطينية, وجيش فلسطيني مربوط بالأردن ماليا، مما بدا فيه أن أمريكا حينها تحصل على موافقة الدول العربية وممثلي الفلسطينيين على مشروعها. ولكن بريطانيا سارعت لعرقلة التقدم، وعاد الوضع في الأردن إلى ما كان عليه من المعارضة، وبتاريخ 21/5/1962 عقد وصفي التل مؤتمرا صحفيا في الأردن كشف فيه أن الأردن يتعرض لضغط شديد لتدويل القدس, وأعرب أنه لن يدوّل القدس، ثم أكّد الملك حسين في لقاء مع ضباط الجيش أنه لن يُدوّل القدس، كما كشفت مذكرة حزب التحرير للملوك والرؤساء في 1962.
وبالطبع ارتبطت مؤامرة تدويل القدس بالعقلية الصليبية وأطماع الهيمنة عليها، وقد سبق ما كان من كلام الجنرال البريطاني عند دخول القدس: "الآن انتهت الحروب الصليبية": وبسبب الأطماع الصليبية في القدس، كان موقف الفاتيكان جليا في رفض فكرة الدولة اليهودية عندما زار هرتزل البابا بيوس العاشر من أجل إقناعه بفكرة قيام دولة صهيونية، وكان رد البابا في حينه لهرتزل (لا نستطيع أن نقبل هذه الحركة... القدس يجب أن لا تكون بيد اليهود). وفي عام 1943م أرسل (الفاتيكان) مذكّرةً إلى الحكومة الأمريكيّة عبّر فيها عن معارضته لإنشاء دولة يهوديّة (أسرار الاختراق الصهيوني للفاتيكان وتهويد الكنيسة).
ومن هذا المنطلق أيضا، شن البابا حملة من أجل نزع القدس من أيدي المسلمين وتدويلها: ففي سنة 1961 أرسل بطريك الموارنه في لبنان، بولس المعوشي، وفدا إلى الأردن لإقناع الملك حسين بتدويل القدس، وتواصل البابا مع زين الشرف والدة الملك حسين بشأن تدويل القدس. ثم ازداد نشاط النصارى فيها من أجل شراء الأراضي حتى أصبحت غالبية أراضي القدس بأيديهم. واستهدفت زيارة البابا بولس السادس للقدس وبيت لحم عام 1962 الضغط على الأردن لقبول تدويل القدس كقضية صليبية مرتبطة بأطماع الصليبين القديمة بالقدس، وعملت أمريكا من خلال البابا على تدويل القدس لانتزاعها من يد المسلمين، مما يعتبر امتدادا للحروب الصليبية ولكن على شكل معركة سياسية. وقد مرّ أن معاهدة سايكس بيكو نصّت على تدويل فلسطين كلها في سياق تمزيق الخلافة وممانعة استعادتها. وبالطبع تكمن خطورة فكرة التدويل على المسلمين في أنها تفرض عليهم محاربة العالم أجمع لدى تحريرها، لذلك فإن النظرة الواعية تقتضي محاربة أي فكرة للتدويل في بلاد المسلمين (التدويل للقدس أو بلد إسلامي) وهو من أفظع ما يتصوره المسلمون.
وهكذا تطور الصراع السياسي حول القضية الفلسطينية، وكان حلقة في صراع سياسي بين بريطانيا وأمريكا على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط, حيث كانت أمريكا تعمل على تصفية بريطانيا من المنطقة ووضعها تحت نفوذها، فيما حاولت بريطانيا الاحتفاظ بنفوذها، مع قبول اقتسامها بينها وبين أمريكا، إلا أن الأخيرة ظلت تصرّ على تصفية بريطانيا.
واشتد الصراع السياسي بين الطرفين واستغلّا رجالاتهما في المنطقة، ورغم إدعاءات أمريكا بمواجهة روسيا (مبدأ إيزنهاور)، إلا أنها حددت خصمها الفعلي في بريطانيا. وضمن ذلك الصراع الانجلو-أمريكي، جنّدت أمريكا في صراعها جمال عبد الناصر وحزب البعث في سوريا، والرئيس الجزائري بن بيلا، فيما جنّدت بريطانيا الملك حسين والرئيس التونسي بورقيبة وحزب الشعب والحزب الوطني في سوريا وسياسيي لبنان. وكان الصراع في الحقيقة صراع تنافس لا صراع إلغاء وجود.
وفي تلك الأجواء من الصراع على النفوذ، تكونت بذرة "الفصائل الفلسطينية"، وفي مطلع العام 1964 أصدرت الجامعة العربية قرارا بتكليف أحمد الشقيري، بوصفه ممثل فلسطين في الجامعة، إجراء اتصالات مع الفلسطينيين حول إنشاء الكيان الفلسطيني، وقدم الشقيري تقريره إلى مؤتمر القمة العربي الثاني في 5/9/1964، وتم اعتماد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية برئاسته (صفحة أحمد الشقيري). ومن الواضح أنها كانت في سياق "مشروع الكيان الفلسطيني" الذي هو ضمن الرؤية الأمريكية، ولذلك تبنّى جمال عبد الناصر إنشاءها، ووافق الملك حسين على إنشائها "بحذر"، إذ ظل معارضا لفصل الضفة الغربية في كيان فلسطيني، وأصر على وجود دولتين هما "إسرائيل" والأردن يجمعهما نظام اتحادي. وتم عقد مؤتمر القمة العربي الثاني ذاك في أجواء التفاعل السياسي، مع تعديلات أضافتها أمريكا على مشروعها عام 1964، والمتمثلة في إقامة ثلاث دول هي "إسرائيل" وفلسطين والأردن يجمعها نظام اتحادي، ومن أجل تلك الغاية كانت قد دعت كل من الملك حسن وايشكول رئيس وزراء "إسرائيل" إلى واشنطن، وبدت في حينها بوادر موافقة بريطانيا على المشروع الأمريكي المعدل.
ولقد كان واضحا للواعين أن الغاية من إنشاء المنظمة هي فصل الضفة الغربية عن الأردن من أجل تنفيذ المشروع الأمريكي بإقامة كيان مستقل فيها، كما حذّر حزب التحرير بتاريخ 19/12/1964 من تلك الخطورة. وفي إطار تلك الصراعات: أُعلن عن انطلاق حركة فتح مطلع عام 1965، فيما كانت قياداتها تتحرك منذ الخمسينات، ورغم مشاركة 20 ممثلا عنها في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، احتجت حركة فتح –في حينه- على تأسيس منظمة التحرير "باعتبارها أداة للدول العربية أقيمت لاستباق صحوة الشعب الفلسطيني" (الموقع الرسمي لحركة فتح).
ومن ثم أطلق بورقيبة مشروعه عام 1965 الذي غلفه بتصريحات متشابكة وتعبيرات متداخلة، منها قوله في زيارته للقدس (من الممكن للعرب واليهود أن يتعاونوا معا على أساس من الاحترام المتبادل)، وقوله (هذه البلاد فيها المجال الكافي لكي تعيش كل الطوائف بعضها بعضا، وبالتعاون والتفاهم يتكون الأساس الحقيقي للسلم)، ومع أن البعض فهم من تصريحات بورقيبة المتداخلة رؤية لكيان فلسطيني، إلا أن حزب التحرير كشف في تعليق سياسي بتاريخ 20/3/1965 بأن مشروع بورقيبة يتلخص بأن تُبنى على أساس "التوازن الطائفي"، مما يعني "إقامة لبنان ثانية في فلسطين, تقوم على أساس توازن طائفي وتهضمها المنطقة كما هضمت لبنان"، وهو يدفع بذلك الرؤية البريطانية أمام تقدم المشروع الأمريكي، فيما تضمن مشروع بورقيبة عودة جميع اللاجئين كتعديل في تلك الرؤية (قضايا سياسية).
واستمرت الأحداث حول ذلك، وتم تجديد صياغة الحل الأمريكي –على أساس الدولتين- في نهاية الستينات تحت عنوان "مشروع روجرز". وفي سياق تلكما الرؤيتين، تم طرح تفاصيل أخرى في بعض المناسبات، منها مثلا وحدة الكيانات الثلاثة أو الاثنين (حسب الحل)، ثم مشروع بورقيبة المعدل الذي جعل الأردن جزء من فلسطين (في سياق لاحق ضمن مقال لاحق).
إن هذه المراجعة لانبثاق الرؤى الاستعمارية لحل القضية الفلسطينية تكشف عن العقلية الصليبية التي كانت طاقة كامنة خلف التحركات الغربية، وتظهر أن أطروحات الحل التي تعددت ما بين التدويل لكل فلسطين أو لمنطقة القدس، وما بين حل الدولة الواحدة وحل الدولتين كانت كلّها حلقات ضمن مسلسل متصل ومتشابك من التآمر الغربي (الذي سخّر اليهود) على المسلمين وعلى قلب بلادهم فلسطين. وأن القضية ظلت لدى أمريكا وبريطانيا قضية إقامة قاعدة ضد المسلمين تحول دون إعادة الخلافة، وتواصل بلاد المسلمين الجغرافي، وفي إطار الصراع الحضاري مع الإسلام. وهما إذ تلتقيان على ذلك، فإنما تختلفان على تفاصيل الرؤى وكيفية تسخير الكيان اليهودي لمصالحهما الرأسمالية، وهما إذ طرحتا رؤيتين مختلفتين، ظلّتا تتنافسان عليهما ،وتتقاربان حولهما أحيانا حسب مستجدات الأحداث ومناخ الأمة وحسب مستوى تقبّلها لوجود دولة اليهود، ولم تكن رؤى مبدئية لا يمكن التنازل عنها.
وأمام هذه الوقفة التاريخية للمراحل السياسية الأولى والرؤى الدولية لحل القضية الفلسطينية يتبين أن ما بات يُعرف بالمشروع الوطني والتوافق الوطني على دولة في حدود عام 1967 ما هو إلا انخراط في تنفيذ الرؤية الاستعمارية الأمريكية القديمة لحل قضية فلسطين، وإن بعض الصرخات التي تنطلق هنا وهناك بين الفينة والأخرى حول الدولة الديمقراطية الواحدة التي تجمع اليهود والفلسطينيين ما هي إلا استجابة لطرح الحل البريطاني، ثم إن التصريحات التي تصدر عن القيادات السياسية حول استجلاب قوات دولية (لحفظ الأمن) ما هي إلا سباحة في مستنقع فكرة التدويل الاستعمارية التي بلورها الاستعمار بعد الحروب الصليبية.