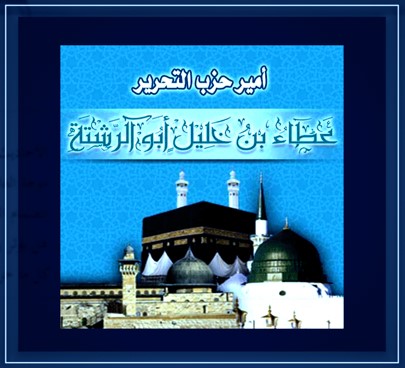حكم الإسلام ... أم حكومات الإسلاميين !
الدكتور ماهر الجعبري
تمخضت صناديق الانتخابات في كل من مصر وتونس عن تأييد كبير لمن يحمل شعار الإسلام، مما يشير بوضوح إلى أن المشاركين قد صوتوا للشعار الإسلامي، وأنهم يتطلعون إلى أن يُحكَموا على أساس الإسلام، وهو مؤشر يكشف عن مكنون الأمة النفيس، ويتوافق مع نتائج استطلاعات للرأي سبق أن قامت بها مؤسسات عالمية، مثل مؤسسة "جالوب" الأمريكية، التي كشف استطلاعها عام 2007 أن أكثر من 90% من "الشعب" المصري يؤيد تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن حوالي ثلثي المصريين يطالبون بجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع، وهنا تبرز لدى المحلّلين تساؤلات حول إمكانية نجاح "الإسلاميين" المنتخبين في "تجربة" الحكم.
من المقبول أن يتوقع البعض أن "الإسلاميين" -بأشخاصهم كحكام- يستطيعون أن يحاصروا مستوى الفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية، وكذلك المحسوبيات، ويستطيعون أن يمنعوا سرقات الأموال العامة، وأن يمنعوا تزييف إرادات الناس في انتخابات زائفة، وأن ينهوا حالات الكبت والقمع الذي مارسته الأنظمة المستبدة، وأن يحسّنوا مناهج التعليم وأن يفتحوا المجال للبحث العلمي المنتج. وهذه الأمور بحد ذاتها إنجازات مستهدفة ضمن مشروع الأمة، وهي لا شك كذلك، ولكن السؤال الأهم هنا: هل تنهي هذه الإنجازات المادية الممكنة حالة الانحطاط التي عاشتها الأمة، وتحرر الشعوب من الارتهان للبرامج والمشروعات الغربية التي عانت منها الأمة طيلة العقود الماضية؟ وهل تؤدي إلى تغيير سياسي-اقتصادي-اجتماعي يعيد الإشراق لوجه الأمة الحضاري ؟
إن مشكلة الكيانات السياسية التي ثارت عليها الأمة تمثلت في أشخاص الحكام الذين انتهى بعضهم، ويترقب البعض الآخر دوره، وفي الأنظمة والدساتير التي كانوا يطبقونها، وفي المرجعيات التي استندت إليها، وفي طبيعة العلاقات الدولية التي صاغوها أو فُرضت عليهم، وفي السياسات الاقتصادية التي أُلزموها، وفي البرامج الاجتماعية –التغريبية- التي نفذوها.
ومن الواضح أن دلالة شعار الثورة "الشعب يريد إسقاط النظام" لا تنحصر ضمن حدود إسقاط أشخاص الرؤساء وتنصيب حكام "إسلاميين"، بل هي تعني أيضا إسقاط كل ما ارتبط به الرؤساء المُسقَطون من سياسات وعلاقات، وبالتالي، فإن الناس التي أسقطت الأنظمة تتوقع من "الحكام الجدد" أنظمة بديلة تماما، تنقلب على "طريقة العيش" الفاسدة التي فرضتها الأنظمة التي سقطت، وتعيد صياغة طريقة العيش على أساس إسلامها الكامن في أعماقها، والذي أشعل فيها الثورة، مع اشتعال النار في جسد البوعزيزي.
ولذلك، فإن التغيير المنشود من قبل من يصوتون "للإسلاميّين"، ومن قِبل من اشتعلوا ثورة ضد الأنظمة السابقة، يتطلب تغيير الدساتير على أساس الإسلام –وحده!- وحل المشكلة الاقتصادية، وإنهاء حالة الهيمنة الغربية على مصالح ومقدرات الأمة، وتحرير البلاد التي رزحت تحت الاحتلال لعقود طويلة، ومسح الخطوط التي خربشتها تلك الهيمنة على خارطة المسلمين، وإعادة الاعتبار لقيم الأمة في الاجتماع وفي الإعلام وفي التعليم وفي الفن وفي السياحة ... وفي كل مناحي الحياة، ومن هنا كان التعبير المتمثل في "تغيير طريقة العيش" هو الجامع لهذا التغيير المنشود على أساس الإسلام. ومن الطبيعي أن من يصوّت للإسلام يريد أيضا أن يحمل الإسلام رسالة خير عالمية (كما حمل الغرب الديمقراطية رسالة عالمية!)، وبالتالي يتطلع إلى صياغة أسس السياسة الخارجية لتصبح قائمة على هذا الحمل للخير كمصلحة مبدئية، كما صاغت الرأسمالية سياستها الخارجية على أساس مصالحها المبدئية في حمل الديمقراطية للعالم، وكما تحاول اليوم محاصرة هذه الثورات ضمن حدود رسالتها "الديمقراطية" هذه.
ولكن المتابعة لبعض تصريحات "الإسلاميين" المنتخبين تدلل على أنهم يحسبون أنهم قادرون على تحسين حياة الناس مرحليا -كما حصل في تركيا- من خلال استهداف منجزات التحسين المادي لجوانب الحياة "المدنية"، ويظنون أنهم قادرون في تلك الحالة على التناغم مع الناس ومع الغرب في آن واحد، في معادلة مستحيلة واقعيا ومبدئيا.
فهم سيصطدمون بمواجهات على عدة جبهات في مسيرتهم تلك، منها فلول الأنظمة البائدة، ومنها طبقة العلمانيين –في خانة المعارضة- الذين ظنوا طيلة العقود الماضية أنهم النخبة البديلة عن الأنظمة المستبدة، وهم الآن يتحركون حركات المذبوح في النزع الأخير بعد فشلهم الانتخابي، وهي حركات خطرة في العادة. هذا عدا عن خوض "الإسلاميين" حالة من الصراع الداخلي في أنفسهم، وفيما بينهم: بين مفاهيم الأعماق التي يحملونها وبين التنازلات المبدئية التي سيدفعونها، في حالة القبول بأن يكونوا "أشخاص حكام جدد" على أساس مفاهيم الحكم والاقتصاد والاجتماع الغربية، والتي تتمثل اليوم في شعار "الدولة المدنية".
إن الدول المدنية-العلمانية- التي أسّسها الغرب على أنقاض الحكم الكنسي الديني، قد آلت اليوم إلى مجموعة من الأزمات الاقتصادية حتى غدت سمة هذا العصر، وتلك الأزمات قد تمخضت عن –وترافقت مع- مشاكل سياسية تهد اليوم بقاء الاتحاد الأوروبي، وتنذر بتحركات جماهيرية قد تتصاعد في أمريكا، كما طفا على شاشات الإعلام في مشهد يشبه ميادين التحرير، مما يؤكد أن نموذج الدولة المدنية، لا ينجح في حل مشاكل الإنسان، هذا عدا عن إفلاسه الحضاري والثقافي والاجتماعي كما تشير الإحصاءات الغربية حول حالات الاغتصاب، وكما تدلل تشريعات الزواج المثلي، وحروب النفط، ومعتقلات غوانتانامو، ومنع مظاهر اللباس التي تذكّر بالإسلام في فرنسا.
وتلك الأزمات التي يعاني منها الغرب هي نتيجة طبيعية للنظام الرأسمالي المهيمن على السياسات الاقتصادية، حيث حصر النظرة للمشكلة الاقتصادية في زيادة الإنتاج، وأغفل موضوع التوزيع، مما أدى إلى تركّز الثروات في أيدي فئة قليلة من أثرياء العالم. ومن ثم تفتّقت الرأسمالية عن مصطلح "الناتج القومي الإجمالي"، وظلّت تراقب زيادته كمؤشر على النمو الاقتصادي، ولكنه بقي نموا "دولة بين الأغنياء" منهم، ولم يتوزع إلا في البيانات الإحصائية، عندما تم تقسيم ذلك الناتج "رياضيا" على عدد السكان، ولم يتم تقسيمه "فعليا" من خلال أنظمة وتشريعات، ومن خلال ممارسات واقعية توصله لأيدي الفقراء، فخرجوا في شوارع الغرب متذمّرين من الرأسمالية ومما تمخض عن دولتها المدنية.
والرأسمالية ابتدعت نظام العملات الورقية وما نتج عنها من تضخم، وابتدعت الشركات المساهمة وما نتج عنها من اقتصاد وهمي، يتحرك على شاشات الحاسوب بمبالغ وأرقام خيالية أكبر بكثير من القيم الحقيقية التي تتحرك على الأرض، وابتدعت برلمانات تصوّت على المسموح والممنوع ولو كان زنا أو زواجا مثليا، ولو كان اتفاقية تقرر احتلال الأرض، وابتدعت الكثير من الأنظمة التي أدت إلى شقاء البشرية كما هو مشاهد ملموس.
إن تمثّل شعار الدولة المدنية لدى بعض "الإسلاميين" المنتخبين، رغم ما آلت إليه عند من ابتدعها كحل للهيمنة الكنسية في أوروبا، يكشف عن حالة مرضية في التفكير لدى بعضهم، حيث باتوا كأنهم يدعون إلى إعادة إنتاج مسلسل التيه الذي عاشه الغرب على أساس الدولة المدنية، متناسين أن الأمة تمتلك الحل الأصيل –ولا نقول البديل- لمشاكل الإنسان.
وإضافة لذلك فإنهم في تلك الحالة يكونون قد تخلّوا عن حمل الإسلام كبديل حضاري يُعيد صياغة الأنظمة السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية وحالات السلم والحرب، بل حملوا رسالة الغرب الديمقراطية، ومن ثم فمن الممكن أن يتحولوا إلى "ساسة-دراويش" تتلاعب فيهم القوى الدولية، وتُسقطهم فيما سقطت فيه من أوحال، ومن ثم يسقطون في أعين الناس، ويفشلون في تجاوز الأزمات الاقتصادية، مما يخلق لهم أزمات سياسية وداخلية لا قبل لهم بها.
إن التخلص من أشخاص الحكام الفاسدين يمكن أن يؤدي إلى طبقة من الحكام "الشرفاء"، ولكنه لا يمكن إن يؤدي إلى حكم رشيد على أساس الإسلام يحقق تطلعات الناس. فهل يلتفت هؤلاء "الإسلاميون" الذين يتأهبون لصياغة الدساتير إلى مبدئهم الإسلامي ويستندون إليه وحده ؟ وهل يطبقون نظراته الإسلامية التي تقلب النظرة الاقتصادية وتصوغ المشكلة الاقتصادية على حقيقتها وهي أنها مشكلة توزيع الثروات بين الناس ؟ وهل يغيّرون وجه الدولة والمجتمع ؟
إن "الإسلاميين" المنتخبَين على مفترق طرق: إما أن يصرّوا على تجريب المجرّب، وإما أن يلتزموا مفاهيم الأعماق التي تتفجر في أنفسهم وتطفوا على السطح في بعض المناسبات الجماهيرية والإعلامية، كما حصل مع الجبالي –رئيس الوزراء التونسي المرتقب- عندما بشّر بخلافة سادسة، وكما حصل مع الشيخ حازم صلاح مرشح الرئاسة المصرية المحتمل، عندما صدع بشرعيّة عودة الخلافة في لقائه قبل أيام مع فضائية مصرية.
ولا شك أن الدعوة لعودة الخلافة لا تستند إلى مجرد استحضار تجربة تاريخية ناجحة ومن ثم إسقاطها على المستقبل، بل هي تستند إلى تطبيق وحي إلهي حدّد نظاما متكاملا لحياة البشر، ومن المعلوم بداهة أنه لا يمكن لمن يعتقد بوجود إله لهذا الكون إلّا وأن يتيقّن بأحقيّته في أن يشرّع للعباد، فهو الخبير بمن خلق وبما يصلح لهم. ومن هنا فلا يمكن لمفاهيم الأعماق لدي "الإسلاميّين" أن تتغير، ولو غطتها دبلوماسية الغزل مع الغرب، ومفاهيم "المرحلية" الخاطئة.
خلاصة القول أن "تجربة" الديمقراطية والدولة المدنية قد فشلت في عقر دارها، وتمخضت اليوم عن أزمات اقتصادية وأخلاقية وسياسية وعن فقدان رسالة خير للبشرية، مما هي من معالم "الدولة المدنية" التي يريد البعض إعادة إنتاجها في الأمة مع وصول "أشخاص" الإسلاميين إلى عروشها.
ولكن نجاح الإسلاميين في الانتخابات بدون برنامج إسلامي خالص لا يمكن أن يؤدي إلى نجاح "الحكم الإسلامي"، ومن هنا فإن "التجربة" القادمة محكوم عليها مقدما حسب جواب السؤال الرئيس: هل تريد هذه الجهات المنتَخبة حكم الإسلام فترضي الله ويرضى عنها عبادُه ... أم حكومات للإسلاميين تطبق نفس الأنظمة التي تمخض عنها الغرب فتُغضب الله ويتمرد الناس عليها من جديد؟
21/12/2011