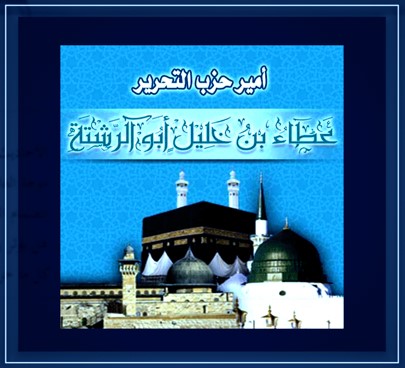تسعى السلطة الفلسطينية كما في بعض دول من بلاد المسلمين، إلى طرح مسودات قوانين، أو تعديلات على قوانين أو مراسيم، أو تعليمات وإجراءات جديدة تريد تطبيقها، تسعى إلى طرحها على الجمهور تحت مسمى "الحوار المجتمعي"، بحسب الأهداف المعلنة لإشراك شرائح المتجمع ومؤسساته المدنية، وكذلك النقابات والقطاع الخاص والقطاع العام وغيرهم في إبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم وتعديلاتهم على ما سوف يتم تنفيذه، كي تصل الدول أو السلطة مع المجتمع إلى صيغ توافقية ترضي جميع الأطراف وتحقق ما يسمى العدالة والنزاهة والشفافية.
كان هذا ظاهرا وجليا منذ أن حاولت السلطة عام 2019 فرض قانون (الضمان الاجتماعي)، ثم بعدها أعادت المحاولة مرة أخرى قبيل أحداث السابع من أوكتوبر 2023، ثم إن السلطة لم تتوقف عن إصدار قرارات بقانون أثناء العدوان على غزة، قوانين وتعليمات لها علاقة مباشرة بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، وتعليمات وقرارات بقانون متعلقة بالشمول المالي، والحد من استخدام النقد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية ... الخ، حتى أن السلطة وعلى موقعها الإلكتروني التابع لوزارة العدل أطلقت (منصة التشريع) للمشاورات العامة، وذلك لطرح مشاريع التشريعات التي تعمل عليها السلطة على الجمهور حتى يتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم عبرها، حيث اعتبرت وزارة العدل أن هذه المنصة هي لإتاحة الفرصة أمام الشعب بالاطلاع والمشاركة في عملية صناعة السياسات والتشريعات بأسهل الوسائل الممكنة، الأمر الذي من شأنه، كما يدعى، أن يعزز من النزاهة والشفافية في العملية التشريعية ويوثق ثقة المواطن بالحكومة.
والسؤال هو، ما هي النتائج المرجوة من تلك الحوارات المجتمعية؟
والسؤال الآخر، لماذا تطرح الدول، أو السلطة الفلسطينية على وجه التحديد مسودات قوانينها وتعليماتها للحوار المجتمعي؟
المشكلة في هذه الحوارات المجتمعية تكمن في حدود هذا الحوار، فما حصل من حوارات يظهر أن المحاورين والمتحاورين يخوضون مباشرة في تفاصيل التشريع وبنوده وانتقاد بعض المواد، وضعف صياغة مادة هنا، أو تفسير لمادة هناك، ومن ثم تبدأ الأسئلة من المتحاورين عن اللوائح التنفيذية، وهذا تحديدا هو الهدف الذي تسعى السلطة الفلسطينية إليه، أي توجيه الأنظار والاهتمام إلى تفاصيل القانون أو التشريع وليس من حيث هو.
لماذا؟ لأن القانون أو التشريع أو التعليمات قد تم وضعها أساسا للتنفيذ، لتنفيذ شروط الراعي الرسمي والضامن الأساسي لبقاء السلطة سيفا مسلطا على الشعب، سعيا لإخضاعه أو تهجيره، سواء لإخضاعه في الجوانب الاجتماعية وتفكيك الأسرة، أو الجوانب السياسية لينتقل من مرحلة شعب يعيش تحت الاحتلال إلى شعب يراد له أن يتعايش مع الاحتلال، أو الجوانب الاقتصادية وخلق بيئة غير مستقرة وغير آمنة للاستثمار والعيش بالحد الأدنى من مقومات الصمود، دفعا بهذا الشعب للهجرة طوعا وترك الأرض لمغتصبيها.
لم يكن القانون أو التعليمات يوما مطروحا للنقاش في ذات القانون، أو حتى جوهره وأهدافه ونتائجه، لأن السلطة ذاتها لا تملك أن تلغي قانونا طلبه الأمريكان أو الكيان منها، ولهذا لا تسمح السلطة بالحوار في أساس القانون، أو نستطيع القول أنها لا تسمح بالمساس بالنقطة الخبيثة التي تشكل جوهر القانون والغرض منه، لأنه وضع للتنفيذ، وما الحوارات المجتمعية إلا وسيلة لاستبدال المداولة بالرفض، والتفاوض بالمواجهة، حتى تنحرف وجهة الجمهور من الاختيار بين السيء والأسوأ، وتتحول المقاييس إلى اختيار أي البنود أقل خسارة من غيره.
والمشكلة أن السلطة تدعي دائما أن الحوار المجتمعي كان شاملا، غير أن الشمول هنا لا يعني التمثيل، بل الانتقاء. فالحوار يُدار مع أطراف لا تهدد الاتجاه العام، ولا تملك القدرة على تعطيله، بل يظهر في بعض الأحيان أن السلطة تحاور موظفيها، أو بشكل أدق تحاور نفسها، أما الصوت الذي يضع القانون في موضع المساءلة الكلية، ويرفضه من حيث الأساس، فلا يُنظر إليه بوصفه رأيًا، بل بوصفه ينتمي إلى جهة تسعى للتخريب، أو تمثل أجندات خارجية، أو جهة تهدف إلى خدمة الاحتلال على حد تعبيرهم، وذلك فما يسمى "بالحوار المجتمعي" هدفه النهائي عادة فرض القانون، ولو اقتضى الأمر بالقوة والبلطجة.
وأخيرا
هل تملك هذه الحوارات عادة القدرة على إسقاط قانون؟
ثم هل يسمح للشعب بأن يقول (لا) دون أن تلاحقه أجهزة المخابرات والأمن الوقائي؟
الحقيقة التي يتم إخفاؤها عمدا أن هذه القوانين لا تطرح للحوار المجتمعي حبّا بالمشاركة، ولا حرصا على الشفافية والنزاهة والعدالة، بل لأن السلطة تبحث عن أقل كلفة ممكنة لمد يدها إلى جيوب الشعب، فيصبح الحوار في هذه الحال أداة تخفيض للحرارة، ودواء مسكنا يستخدم لتمرير سياسات جباية لتجنب حراكات واسعة، ودون مواجهة مباشرة مع الشارع.
هذا ما تحاول فعله الأنظمة في بلاد المسلمين، وتحاوله السلطة، وبالمقابل فإن الإسلام لم يجعل القوانين موضعا للخداع في استصدارها، وإيهام الناس أنهم شركاء فيها، ولم يجعلها مجالا للاختلاف في مضامينها، ولا يضع الناس تحت نار وآثار فشلها كما هو معتاد في القوانين الوضعية البشرية، لأن ما جاء به الإسلام تشريع إلهي، لا يأتيه الباطل، ولا تنقضه التجربة، وهو لا يحتاج إلى نقاش حول هل تغلب القوانين مصالحها مفاسدها أم العكس، سواء أكان الحوار في البرلمانات أم في غرف التجارة والصناعة أم في النقابات، فإنه يكفي في الأحكام الشرعية كي تطبق بين المسلمين وعليهم، أن يُشار إلى دليلها الشرعي من الكتاب أو السنة حتى يأخذها المسلمون دون أن يجدوا في أنفسهم حرجا.
والخلاصة أن هذه الحوارات في الإصلاحات المالية، أو الشمول المالي، أو قانون الضمان الاجتماعي، أو في تحديد سقف استخدام النقد وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، وقانون التجارة الإلكترونية، ما هي إلا مشاركة للشعب بشكل "شكلي" في تفاصيل سرقتهم ونهب أموالهم والسيطرة على مواقفهم، وقياس مدى احتمالهم للظلم، إلا إن أعلنوا الرفض وأعلوا الصوت في وجه الظالمين وأسيادهم وأعوانهم.
أ. صابر حسين
07/01/2026