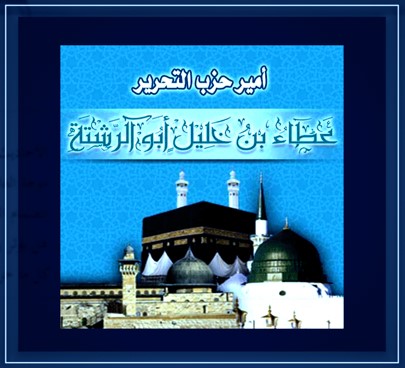الانتخابات...وأوهام التغيير
-1-
بقلم: يوسف أبو زر
 كثيرا ما تلجأ الأنظمة والحكومات الفاشلة لإنقاذ نفسها، و خاصة إذا ما استهلكت ذاتها واهترأت شرعيتها أو انسدت آفاقها إلى الانتخابات، وتحت خديعة التجديد والإتيان بالجديد تجري الانتخابات بخداع من القوى النافذة وباستغلال لهفة البسطاء إلى التغيير، وإذا بهم يعيدون أنفسهم بذات المنهج البائس حتى وإن تغير بعض الأشخاص، وإذا بهم يشترون زمنا جديدا يمتدون فيه.
كثيرا ما تلجأ الأنظمة والحكومات الفاشلة لإنقاذ نفسها، و خاصة إذا ما استهلكت ذاتها واهترأت شرعيتها أو انسدت آفاقها إلى الانتخابات، وتحت خديعة التجديد والإتيان بالجديد تجري الانتخابات بخداع من القوى النافذة وباستغلال لهفة البسطاء إلى التغيير، وإذا بهم يعيدون أنفسهم بذات المنهج البائس حتى وإن تغير بعض الأشخاص، وإذا بهم يشترون زمنا جديدا يمتدون فيه.
إن الانتخابات، أية انتخابات -على افتراض النزاهة وسلامة الظروف والخلو من المؤثرات- لا تنتج تغييراً بذاتها، وإنما بمحتوى ما يطرح فيها من برامج وما تعكسه من تغيرات في المجتمع، فإذا كانت المناهج القديمة والبرامج السقيمة هي المطروحة بذاتها وعلى حالها، فلن تكون الانتخابات حينئذ أكثر من شرعنة وتثبيت وتجديد وتكرار للفشل والفساد، وإضافة مؤسسة عقيمة إلى بقية المؤسسات، ولعل هذا هو الظاهر البارز في الانتخابات الفلسطينية كما هو الظاهر والمعتاد في منطقتنا العربية بالعموم.
من يروج للانتخابات الفلسطينية والمشاركة فيها هم فريقان من الناس:
أما الفريق الأول فهو الذي بادر لهذه الانتخابات وأعلن عنها وهي السلطة الفلسطينية، ومعها في ذلك الفصائل، وخلف ذلك دول كبرى لا تجري الانتخابات إلا بتدابيرها ورضاها، ولكل من هذه الأطراف حساباته الذاتية في هذه الانتخابات، سواء من أراد منها تجديد نفسه وشرعيته المهترئة كالسلطة، أو من أراد التموقع في ظلال كيان السلطة لئلا يجد نفسه خارج الأطر المقبولة "دوليا" وليضمن حضوره السياسي في أية مرحلة مقبلة كالفصائل بشكل عام، وخلف ذلك تقف دول كبرى تهدف من الانتخابات –إن كانت جادة فيها- أن تجدد شرعية السلطة وأن تعيد اصطفاف القوى الفصائلية تحت خيمتها فتكون جاهزة لأي تحريك للقضية الفلسطينية.
وأما الفريق الثاني، فهم أولئك الذين ينظرون إلى الانتخابات على أنها فرصة يحلمون من خلالها بالتغيير، ويطرحون شعارات شتى للحض على المشاركة في الانتخابات ترشيحا وترشحا بحجة محاربة الفساد والفاسدين وترغيبا في التغيير، وهؤلاء ليسوا فواعل في هذه الانتخابات إلا أن يكونوا وقودها، وذلك لأن غرض المبادرين إليها وكذلك الإطار الذي يحكمها وسقف الاحتلال الذي يعلوها يحول دون أن تكون هذه الانتخابات عملية طبيعية لاختيار ممثلي الناس أو إسماع صوتهم وممارسة إرادتهم، فهذه ليست لتلك.
ولأنه كما يقال أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كان لا بد من تصور واقعي للانتخابات الفلسطينية ليكون الحكم على واقع المشاركة فيها، وهو ما تناقشه هذه المقالة، وذلك لأن هذه الانتخابات لا ينفع تجاهها الحياد بل لا بد فيها من موقف واضح، فهي ليست كأية انتخابات وذلك لارتباط الانتخابات في فلسطين عادة بالتسويات السياسية، والكلام في غالبه في هذه المقالة هو موجه للفريق الثاني، وهم كثرة من الجماهير يدركون فساد الواقع ولكن يخشى عليهم من شعارات التغيير الزائفة الساذجة المخادعة من أن تجرفهم عكس المطلوب، فيكونون وقودا لتجديد "منظومة الفساد والتفريط " وشرعنتها ونفخ الحياة فيها، حتى إذا ما جرى ذلك تم الدخول إلى مرحلة جديدة من الفساد والتنازل والتفريط، وكان ذلك بختم من الجماهير المشاركة.
ومن هنا فان إحسان التصور لقضية الانتخابات يوجب الوقوف على أمور لا يصح إهمالها والتغافل عنها بحال من الأحوال.
لم تكن الانتخابات الفلسطينية التي أعلن عنها بناء على رغبة الناس ولا تحقيقا لمطلبهم، لا هذه المرة ولا في المرات التي سبقتها من الانتخابات، فالانتخابات تم تعطيلها لما يقرب من خمسة عشر عاما دون النظر إلى الناس أصلا ودون اعتبارهم، ولذلك كان هذا الفريق وهو الذي قررها ابتداء هو صاحب التوقيت والغرض، فتاريخ الانتخابات الفلسطينية يقول أنها لم تكن يوما ناحية مطلبية لتجديد تمثيل الناس، بل ولا حتى ذاتية، وإنما كانت مواقيتها محطات لمشاريع الدول الكبرى، كالانتخابات الأولى عام 1996 والتي كان المقصود منها صنع الشرعية لأصحاب أوسلو وشرعنة مفاوضاتهم التي تلت أوسلو، مع أن أوسلو ذاتها، وهي التي قررت صيغة حياة أهل فلسطين فيما بعد، لم تكن بناء على رغبة الناس أو مشورتهم، وكذلك كانت الانتخابات الثانية عام 2006 كمتطلب من ضمن مراحل خارطة الطريق التي وضعها الأمريكان.
من هنا فإنه ينبغي لكل من ينظر للانتخابات -بحسن نية- على أنها فرصة للمشاركة فيها ولو من الناحية المطلبية التحسينية لحياة الناس، ويوهم نفسه بأنه سيكون صانع القرار وصاحب الاختيار، أن يدرك أن واقعها هو غير الأمنيات، وأن الغرض الأصلي منها ليس هو المتوهم، وأن "الطغمة الفاسدة" ما كانت لتبادر بالانتخابات لتمكين الحالمين من القضاء عليها وعلى فسادها، فذلك من سوء التقدير.
إن الشعارات التي تروج للانتخابات على أنها فرصة للتغيير هي شعارات خادعة، وهي في جلها شعارات قديمة مستهلكة ومكررة عند كل انتخابات، وعلى رأس تلك الشعارات يأتي موضوع محاربة الفساد والفاسدين، ومع أن الانتخابات لم تطرح لتكون فرصة لمحاربة الفساد، إلا أن هذا الشعار يستحق الوقوف عنده للتأكد من وضوح الفساد كمفهوم قبل الانتقال إلى شعار محاربته.
إن التصور بأن الفساد هو مسؤول مرتش أو مستغل لسلطته هنا، أو موظف معيّن بالواسطة هناك، أو أنه احتكار لشركة كبيرة في مجال ما، هو تصور بسيط بل سطحي للفساد، لأن هذه الأمور هي بعض مظاهر الفساد وجوانبه وليست أساس الفساد،فعوضا عن وجود الفساد الكبير العريض في الأرض المباركة والذي يتمثل في "كيان يهود" واحتلاله، فإن الفساد كامن أيضا في طبيعة كيان السلطة الفلسطينية ودورها الوظيفي، بل إن الفساد هو من دورها الوظيفي، وقد تحقق ذلك فعلا، فهي التي أفسدت حياة أهل فلسطين ومعيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، وهي التي أفسدت قضيتهم حتى آلت إلى وضعها الحالي بوصفها -أي السلطة– هي الجهة المعتمدة المنفذة لصفقات التنازل، وهي التي أفسدت -إن دق التعبير- "حالتهم الثورية" بتنسيقها الأمني المقدس وسراب "مشروعها الوطني"، ذلك المشروع الذي دفع الناس تكاليفه الباهظة من جيوبهم فما زادهم إلا رهقا، وهي التي شرعت الأبواب وكسرت تحصينات المجتمع عندما سمحت ورعت فساد المؤسسات التغريبية لتفسد النواحي الاجتماعية.
لذلك فإن هذا الكيان الوظيفي "السلطة " سيكون بالضرورة فاسدا لفساد وظيفته وأساسه الذي قام عليه، وهذا الفساد المشار إليه هو فساد بنيوي، أي في بنية كيان السلطة الفلسطينية وتركيبتها وقوانينها بحيث لن يسع الداخل في السلطة ومجالسها إلا التعامل مع هذا الواقع، وهذه الطبيعة الوظيفية هي من الأمور التي لا يسمح الخارج، الراعي والداعم، بتغييرها لأنها جوهر وجود السلطة، وهي الإطار الذي ستجري ضمنه أية عملية انتخابية، ولذلك فإن ما ستفرزه الانتخابات محكوم باعتبارات الرضى والقبول للدول الكبرى الغربية و"المجتمع الدولي"، ومحكوم بالدور المحدد للسلطة ومسقوف بسقف الاحتلال، وهي حالة من الفساد لا يستطيع الداخل في السلطة وانتخاباتها تجاهلها عوضا عن تجاوزها.
"يتبع"